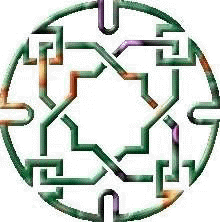
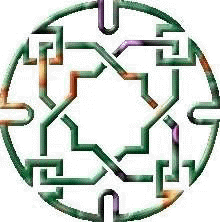


الإسلام والغرب: طرق استعادة الانفتاح على الآخر: حوار مع محمد عابد الجابري
حاوره: نينازو فرستنبرج/ترجمة ضياء الدين عثمان حاج أحمد

موقع حكمة
مقدمة الـ حوار
“أترانا مدانون لبقائنا أسرى لمنطق الحرب؛ ذلك المنطق الذي يعجزنا عن تصور العلاقات مع غيرنا دون أن نستدعي في أذهاننا العدائيات أمثال: الخطر، و الموقف المعادي، والصراع، و التهديد؛ الخ؟
تعالت الاصوات في الدول الغربية – تقريبا في كل مكان – ضد هذه الطريقة في رؤية مستقبل العلاقات ين الغرب و بقية العالم. الناس بدأوا يشككون في المعنى الحقيقي لهذا التوصيفات الثنائية المؤسفة، و اشتعالها على إخفاء الحقائق. ماذا تعني – حقاً – ثنائية الشرق / الغرب خلال تاريخ التوسع الأوروبي؛ أي منذ روما إلى امبراطوريات الاستعمار الحديث؟ ماذا تعني بديلتها المنتشرة الحالية: ثنائية شمال / جنوب؟ ”
نشر جزء من حوار مع محمد عابد الجابري في خريف عام 2006 في مجلة ريست الإيطالية.، بمناسبة مرور الذكرى العاشرة لوفاة الفيلسوف الكبير (توفي في 2010)، فنحن سعداء بنشر حوار مع محمد عابد الجابري كاملًا للمرة.
حوار مع محمد عابد الجابري
في كتابك عن “العقل العربي”، أشرت في إحدى النقاط إلى أن المستقبل سيكون رُشدياً (نسبة إلى الفيليلسوف العربي ابن رشد). أكنت تتهكم أم كنت تشير إلى معنى محدد لهذا الوصف؟
لقد كنت أخاطب العرب والمسلمين، فابن رشد هو [فيلسوف] عقلاني كان قد تفهم الفكر الغربي تفهماً عميقاً؛ أي الأرسطية في زمنه، مثلما كان متبحراً في الفكر الإسلامي. فكرة ابن رشد كانت تنبني على أن العقلانية النقدية التي نشأت في الأندلس، أي في أحضان الثقافة العربية الإسلامية، لكن ما جرى تاريخيا هو أن هذه المدرسة الفكرية هاجرت نحو الغرب. بعد ابن رشد بدأ الانحطاط في المشرق، و في الأندلس، و في المغرب، و في ديار الإسلام، لكن المستقبل الذي تشوق إليه ابن رشد تحقق في أوروبا في القرن الثاني عشر؛ أي مع بداية عصر النهضة.
و جنبا إلى جنب مع سبينوزا و كانط و غيرهم، تبوأ ابن رشد مكانا سامقاً في الثقافة الأوروبية عبر القرنين السابع عشر و الثامن عشر و حتى القرن الـتاسع عشر. و أعتقد أن هذا المستقبل الذي لم يتحقق للثقافة العربية الاسلامية يجب أن تعاد ولادته من جديد، و هذا يعني أن مستقبل الثقافة العربية الإسلامية و مرتكزاتها (الفكرية) يجب أن يكون “رشدياً”؛ أي منفتحاً، كما كان ابن رشد.
يجب أن تكون هذه الثقافة عقلانية نقدية، ثقافة مزودة بمعرفة عظيمة بالتراث العربي الإسلامي، و أيضاً بالغرب و تراثه، و الذي كان متمثلا في ذلك الوقت في أرسطو و الفلسفة اليونانية.
هذا ما قصدته.
في حديثك عن العقلانية النقدية وعن “نقد العقل العربي”، كنت تستخدم لغة (نموذج) إيمانويل كانط. ماذا تقصد بالضبط؟ هل تقبل هذا النموذج دون الخوف من أنك قد تهاجم باعتبارك توشك أن تقترح النموذج الغربي و الأوروبي [للتبني] للمرة الألف؟
لا. أنا أعرف بالضبط ما الذي قلته.
الروح النقدية أو العقلانية النقدية التي أتكلم عنها ليست تعزى أساسا لكانط، لأن كانط كتب أعماله في القرن الثامن عشر. [في ذلك الزمن] لم يكن العلم هو ذاك الذي عناه نيوتن و أورده في مدونته الكبرى، لأن نيوتن لم يكن قد أتى بعد. فمن أجل أن يكون لدينا كانط، فإننا بحاجة إلى أن يكون لدينا نيوتن أولاً.
لذلك، أعتقد أن هناك ضرورة لـ[اعتماد] تطور علمي مثل ذلك [التطورالداروني] الذي غير في مجمل طرق التفكير. على أي حال و كما هو معروف، فقد رددت مرارا وتكرارا أن [نقدي] هو نقد فلسفي معرفي بالمعنى الذي يحيل إلى علم فلسفة المعرفة الحديث؛ و هذا يعني أنه علم نقد أنساب معرفية يقترح الكشف عن أسس تراثنا الثقافي، و تحليل الأهمية المعرفية لجميع أنواع المعارف، و ذلك في إطار علوم الفقه و علم الكلام ، و كذلك علوم الفلسفة و علوم التاريخ، الخ.
و عندما أتحدث عن نقد فلسفي معرفي، فإنني أستبعد تماما هنا النقد الأيديولوجي. أنا لا أستعمل النقد الأيديولوجي مع أي مدارس فكرية، حديثة كانت أم قديمة. لا أفعل ذلك. النقد الفلسفي المعرفي يكمن في تحليل النظام المعرفي في جميع المجالات؛ أي الأسس المعرفية للخطاب اللاهوتي العلمي الحديث.
تكمن أصالة مشروعك [الفكري] في إيلائه الاهتمام بالعلم، و بفلسفة المعرفة لدى ابن رشد و لدى كانط، و بالفلسفة النقدية، ثم بببحوثه المتقدمة في أسس التقنيات و العلوم. كما أن كتبك مقروءة من قبل تقريبا جميع الشباب، و في الجامعات، و بين جميع المدارس الفكرية؛ سواء كانت ماركسية، أوعلمانية، أو متأسلمة، أو حتى متطرفة؛ جميعهم يحيلون إلى أفكارك. كيف تفسرون ذلك؟
ربما يعود ذلك، باحتمال مقبول، لتجنبي الماجدلات و الخوض في صراعات أيديولوجية، ولتركيزي على [البحث في] منهجية و أسس المعرفة، منحياً – بذلك – الأيديولوجيات جانباً. كل ذلك من أجل هو تحليل الأفكار؛ ليس بالدرجة الأولى باعتبار فحواها، لكن بالأحرى باعتتبارها أدوات لخلق المعرفة العلمية و الأيديولوجية.
إذن لم يؤدّ العلم نفس الدور الذي أداه في التجديد الثقافي الذي جرى في أوروبا. لماذا؟
لأنه لم يتجاوز أبداً أصوله اليونانية. الحضارة العربية الإسلامية ظهر فيها عدد من الفلاسفة الكبار مثل: ابن سينا و ابن رشد، لكن بالنسبة إلى العلوم المبنية على الاستقراء و الممارسة فبقيت مقتصرة على فقهاء الشريعة وحدهم، و هم الذين كانوا يهتمون بالـ “مفصل”، و بالـ “وقائع”، كما أنهم مارسوا القياس. أما الفلاسفة فظلوا منساقين إلى “الكلي” و “المجرد”؛ بعبارة أخرى أي: القياس المنطقي اليوناني الأرسطي، فدرسوا الطبيعة باستخدام الميتافيزيقيا، في حين قام العلماء بدراسة الظواهر الطبيعية من وجهة نظر مختلفة؛ و هي “أسباب الحدوث”.
و بالتالي العلوم، بالمعنى الدقيق للكلمة، لم تكن تقف إلى جنب الفلسفة في صراعها مع الدين، كما حدث في أوروبا، بل عملت في كثير من الأحيان خارج هذا الصراع. و كانت النتيجة أن في الإسلام لم يمارس العلم نفوذه على العقل. النموذج التجريبي لم يكن موجوداً حينها؛ لأنه ولد مع النهضة الأوروبية. لكن مع استخدامه بدأ تصور الأحداث على أنها تحدث لسبب ، كما يجري في الطبيعة. الأحداث “لها أسباب”، و صار العقل ينظر في هذه الأسباب. من الواضح أن العالم الجديد [حسب التاريخ] كان [قد بدأ من] هنا بالضبط.
لكن في نفس الوقت الذي بدأت فيه نهضة أوروبا، بدأ الانحطاط في عالمنا. ثم جائت المدارس الفكرية العرفانية، ثم غزوات التتار و المغول و العثمانيين، ثم الاستعمار الغربي. [هكذا ترين أن] قصتنا مختلفة تماما.
بما أنك ذكرت الموروث الصوفي (العرفاني)؛ هناك [باحثون] كثيرون يدرسون الطريقة التي يمكن بها تسريع [وتيرة] التحديث في العالم العربي الإسلامي بشكل عام. بهذا المعنى هل هناك حاجة لنوع من الحركات الإصلاحية؟ يعتقد البعض أن الحركة الإصلاحية الأكثر نجاعة لمستقبل التحديث هي: الإصلاحية المعقلنة. بينما يرى آخرون، مشيرين إلى قضية التصوف،أن هناك بديلا آخر يتمثل في اللجوء إلى حركة إصلاحية روحية. ما هو موقفكم حول هذا الموضوع؟
لقد شرحت هذه النقطة في غير كتاب من كتبي. في رأيي: أن التصوف هو تجربة شخصية، و هو من الوسائل المفيدة في مجابهة الأزمات و القضايا الشخصية، أو الأزمات الميتافيزيقية – إذا راق لك التعبير. إذن فهو مسألة فردية، و لا يمكنك أن تنهضي بأمة بناءاً على مفاهيم التصوف. إنه يعني الاحجام عن التصدي للعالم؛ أي أنه نقيض للنهضة، و نقيض للتجديد، و هو في الاتجاه المعاكس للعلم، كما تعلمين جيدا. وبالتالي فإن أي شخص يعاني من مشاكل في حياته، أو في نفسه، أو في وجوده، ربما قد يجد حلاً في التصوف. هو اتجاه أقرب إلى الوجودية أو الروحانية التي تحدث عنها برغسون.
أما تنظيم ثورة، أو إعادة إحياء [حضارة]، أو بناء أمة، أو إنشاء علوم فلا يمكن أن يحدث مع وجود التصوف. أرى الانسان في أمس الحاجة إلى العقل و العقلانية، و أقول أنني منحاز لصالح العقلانية بشدة؛ فبدونها لا يمكن للانسان أن يحصل على العلم و التكنولوجيا، و لا أن يقيم ديمقراطية. العقلانية لا يمكن فصلها من الديمقراطية، و هي أساس الفكر الديمقراطي، و لا يمكن تحقيقه إلا بها. هذا هو الجانب الفلسفي للقضية، لكن لا بد من الاعتراف أن في العالم العربي و الاسلامي هناك معضلات في التحديث، و في التطور المتدرج، و في تنمية العلوم و المجتمعات، و هي مشكلات مركبة، و تعتمد – أيضا – على مؤثرات أخرى.
أتقصد مؤثرات خارجية و دولية و سياسية؟
طبعا.
دعينا نأخذ لبنان على سبيل المثال، فالأحداث الأخيرة في لبنان (حرب العام 2006) لها أهمية كبيرة في سياق المعنى هنا.
لماذا؟
لأن لبنان هو البلد العربي الأكثر حداثةً بالمعنى الذي جائت به الفلسفات، و هو البلد الذي توجد فيه تعددية دينية، و يمكن اعتباره بلد علمانيا على الرغم من وجود طائفية به. في كل الأحوال، فإن لبنان بلد ظل قادراً على أن يتعايش في تناغم مع الغرب، كما حدث دائما، منذ القرنين الثامن عشر و التاسع عشر. لكن انظري ماذا يحدث في أيامنا هذه؟
هناك إشكالية يشكلها [وجود] حزب الله. فحزب الله هو الحزب الذي حرر لبنان، كما أنه يحظى بشعبية و يتمتع بهيبة. ومع ذلك، فإن وضعيته – باعتباره حزب تحرير و مقاومة – تعتمد على تحرر البلد بأكمله. كان يمكن أن يكون إخلاء مزارع شبعا و الافراج عن السجناء العشرة أو الأحد عشر (بالتأكيد هم أقل من اثني عشر) كافياً لكي تحل المشكلة اللبنانية. [لكن] لو حدث ذلك، فإن دور “المقاومة” الذي يؤديه حزب الله لن يكون له أي سبب للوجود. إذ ماذا سيفعل حزب الله لو تم إنهاء الاحتلال الاسرائيلي و أعيد الأسرى لبيوتهم؟ حينها لن يبقى للمقاومة ما يبرر وجودها بأي حال من الأحوال. و في هذه الحالة سينبغي للمؤسسة العسكرية في حزب الله أن يعاد دمجها في الجيش الرسمي، أو تلقي السلاح إلى الأبد. لكن إسرائيل (ومن خلفها الولايات المتحدة) تفضل أن تترك دائما إشكالات غير محلولة مع العرب.
فكري معي: ما الذي يهم فيما إذا كانت كيلومترات قليلة من مزارع شبعا لبنانية أو سورية؟ ما مدى أهمية أسر عشرة أو اثني عشر إسرائيلياَ لسنوات و سنوات؟ لم لا يفرج عنهم؟ يمكن للمرء أن يقول أن حزب الله قام بإجراء لم يكن له ما يبرره في ذلك الوقت، لكن في منطق المقاومة من أجل التحرير فإن مثل هذه الإجراء دائما ما يعثر له على مبرر. و طالما استمرت إسرائيل في احتلال أراضيه، فإن الشعب اللبناني سيستمر في اعتبار حزب الله منظمة ضرورية، و سوف يعتبر الأحزاب و الطوائف ذات التوجه الغربي – و التي تنأى بنفسها عن المقاومة – فقيرة في حسها الوطني، و بالتالي لن يمنح دعواتها للديمقراطية و الحداثة أي مصداقية على الإطلاق.
بالنسبة لمسيرة التحديث فإن هذا الوضعية تبطأ من وتيرة التطور. إن تدخل إسرائيل المحتلة (و حاميتها الولايات المتحدة) يثبت أن [معتنقي] الأصولية على حق. و بالمناسبة الأصولية كلمة تعني في اللغة العربية “العودة إلى الجذور الأصول”. نفس الشيء فعله الأمريكيون في العراق. نظام صدام حسين بالتأكيد كان شمولياً ، لكنه قطعاً لم يكن الوحيد في الشرق الأوسط.
لقد كان نظاماً يمكن للمرء أن يصفه رسميا بأنه نظام علماني، و نجح في “إنتاج” نخبة علموية داخل مجتمعاته، بل و تمكن من محو كل [النتوءات] المتطرفة فيها؛ حيث كان لدى السنة و الشيعة طموحاتهم التقدمية – القومية بالتأكيد – لكنها لم تكن طموحات معادية للغرب. و بدلا من مساعدة دولة علمانية و حديثة [كهذه] لكي تصبح دولة ديمقراطية، قامت الولايات المتحدة بتدميرها؛ متيحة بذلك فرصة البروز لقوى رجعية ملتفتة إلى الوراء و تدعها تأكد صدق دعاواها.
إذا حلل المرء التاريخ المعاصر للعالم العربي من هذا المنظور، فلا بد أن يصل إلى استنتاج مفاده أن كل محاولات التحديث التي تمت من قبل القوى الغربية الإمبريالية قد بائت بالفشل. استمر الفشل بدءا من رائد النهضة المصرية محمد علي، (1805-1848)، و امتد وصولا إلى صدام حسين. و لولا هذا المؤثر الخارجي، لكان تطورنا مشابها لتطور أوروبا.
ترقت أوروبا نحو الحداثة بسبب عدم وجود عراقيل خارجية، بل بالأحرى تعززت قدرتها على تجاوز مشاكلها الداخلية بفضل تدخلاتها الاستعمارية الخارجية. على كل حال، الأحداث في أوروبا كانت محكومة بتناقضات داخلية مهدت لآفاق من الفائض الدياليكتيكي. أما في العالم العربي، فقد أعاق – دائما – التدخل الأجنبي عملية التطور، بل و فرض ديالكتيكاً سلبياً لا تدع النقائض فيه أي فسحة لابتكار التراكيب و تلاؤمها.
في رأيك، هل التأخير و الإخفاق التنموي يعود إلى التاريخ السياسي أي إلى تدخل القوى الغربية؟
بعبارة أخرى إلى تاريخ الاستعمار؟ هل تجزم أن هناك أيضاً أسباب ثقافية و دينية جزماً لا مظنة ؟
الإخفاق الذي ذكرته بالتأكيد كان موجودا؛ لأنه تم تجديد العقل الأوروبي مع ولادة العلم الحديث، و نحن ندرك جيدا أنه مع غاليليو غاليلي، و بيكون، و ديكارت، و باسكال، و مع التقدم التقني و العلمي المحرز في القرنين الـسادس عشر و الـسابع عشر، فإن العقلانية في أوروبا اكتسبت حيوية جديدة؛ حيث تم تجديد العقل الأوروبي بولادة العلم الحديث.
في العالم العربي الإسلامي لم يكن هناك علم حديث. هذه هي المشكلة. في الأصل، العلوم العربية الإسلامية كانت علوماً يونانية، و هي بدورها أدت إلى عدد من التطورات؛ لكنها لم تؤثر على الفلسفة أو اللاهوت مثلما حدث في أوروبا منذ القرن السادس عشر فصاعداً.
يمكن للمرء، على سبيل المثال، الإشارة إلى الطبيب الكبير ابن النفيس، الذي اكتشف مبدأ الدورة الدموية قبل وليام هارفي 1578-1657 (الذي درس الطب وعلم التشريح في إيطاليا) بوقت طويل، و كان أيضا فقيهاً. كتب [ابن النفيس] كتاباً يناقض فيه الرواية الفلسفية: (حي بن يقظان) التي كتبها ابن طفيل (صديق ابن رشد)، و فيه يثبت أن الانسان يمكن أن يكتشف الله باستخدام العقل وحده. لقد قام طبيبنا بالاجتهاد ليثبت إمكانية معرفة النبي محمد نفسه باستخدام العقل وحده – ليس العكس. دعونا نذكر هنا أيضاً ابن الهيثم – ذلك العالم الشهير في مجال البصريات الذي أثر في باسكال و غيره، و كان أيضاً فقيهاً خارجاً صميم الثقافة الإسلامية.
هناك في جميع الحضارات – سواء كانت قديمة أو حديثة دائما – مساحة [لأسباب أخرى كـ] التطرف الديني أو غيره. [لكن] في الظروف العادية فإن مصير هذا النوع من التطرف هو أن يظل هامشياً. هناك تطرف – أيضا – في الولايات المتحدة مع [بروز] المحافظين الجدد، و هناك الكتائب الحمراء في أوروبا. التطرف باعتباره أيديولوجيا و باعتباره الحركي، وجد دائما في كل الحضارات، بيد أنه في لبنان عندما ضرب التدخل الأجنبي منارة الميناء والشوارع والجسور و منازل المدنيين، فهو في الحقيقة قد قام بتعزيز التطرف الديني.
في هذه الحالات، يجد الشعب اللبناني بأكمله – و بما فيه من نخبة – أنه مضطر لدعم حزب اللهز حدث نفس الشيء بمصر في عام 1956، و بالعراق، لما عانى الشعب العراقي لمدة عشر سنوات كاملة بسبب الحصار الشامل المفروض عليه من قبل الأمريكيين. في العالم الإسلامي قام الاستعمار الأجنبي الغربي و التدخل الإمبريالي بزرع التطرف في قلب المجتمعات بدلا من أن ينفياه إلى أطرافه. عندما تجد الحركات المتطرفة نفسها في قلب المجتمع، و عندما لا يتصدى أحد للتدخل الإمبريالي، فإن أيدولوجية تلك الحركات تهيمن على المجتمع بأسره. عندها تخفت الأصوات الليبرالية حتى تبح؛ لأن من المستحيل أن يقف أحدنا إلى جانب الغرب و هو يعتدي على وطنه.
نحن سنقف مع الغرب عندما يعرض السلام، و [بإمكاننا أن] نوافق على ديمقراطية الغرب، و علومه، و قيمه الإنسانية … لكن كل ذلك [يجب أن] يأتي في سياق التعاون و السلام. لكن عندما يعتدي علينا الغرب متنكراً لقيمه هو نفسه، فنحن مضطرون لأن نسأل أنفسنا لم يفعل الغرب ذلك: أمن أجل قليل من السجناء؟ ةأم من أجل أرض لا تتعدى مساحتها بضعة كيلومترات؟ أم من أجل النفط؟
سيتحصل الغرب دائماً على نفطه “منا” نفطـ ؛ لأننا – نحن الدول العربية و إيران و غيرها من بلدان العالم الثالث – نحتاج و سنحتاج دائما للغرب؛ ليس فقط لأنه يشتري نفطنا فحسب، بل أيضا لأنه يساعدنا على استخراجه من أعماق الأرض، و لأنه يستهلكه و يتاجر به. إن ما يبعدنا عن الغرب هو نزوعه للهيمنة، و روحه الإمبريالية. ذلك هو الذي يؤثر كثيراً في كل الاتجاهات المعتدلة بالعالم العربي، و يصب في صالح التطرف الديني أو القومي. لو كان هذا العصر ماركسياً، فيمكن للمرء أن يتيقن أن الشباب الذين يقاتلون الآن لصالح حزب الله كانوا سيقاتلون إلى جانب الماركسيين أو الماويين. إنه النضال نفسه، و هو ليس نضالاً معتمداً على أسباب دينية، بل هو استجابة بلد، و استجابة شعب. الماركسيون و الليبراليون و أصحاب الأسباب الدينية كلهم لهم نفس النضال. لست أفرق بين الماركسي و صاحب الأسباب الدينية. الأيديولوجيات دائما تؤدي دور التعبئة إياه مرة بعد مرة؛ سواء كانت ذات سمات ليبرالية أو إسلامية، ماويية أو لينينية.
إذن أنت تقر أن هناك ضرورة للانعتاق من الكراهية الناتجة عن معاداة الاستعمار، و أن الغرب عليه أن يغير أساليبه، و يتوقف عن الإساءة إلى الشعوب العربية.
لكن لتحقيق ذلك لا بد من تجاوب من الطرفين.
مثلاً: فبفضل ثقافتها و بفضل تعاليم غاندي استطاعت الهند أن تفعل ذلك؛ حيث استطاعت التغلب على الكراهية الموجهة ضد الانجليز.
هل الثقافة العربية قادرة على شيئ من هذا القبيل؟ ما هو الحل الذي تتصورونه لهذه الوضعية المليئة بالكراهية؟
اسمحي لي أن أحكي لك هذه القصة.
بعد شهرين من نشر هنتنغتون لمقالته الشهيرة حول “صدام الحضارات”، دعيت لحضور مؤتمر بشأن هذه المقالة في جامعة برنستون في الولايات المتحدة. و حضر هنتنغتون نفسه إلى المؤتمر.
[حين قابلته] قلت له: ” مقالتك معدة إعداداً جيداً، و استخدمت فيهاً نوعا من التحليل الماركسي، لكن ما النتيجة التي خلصت إليها بالضبط؟ إنها استدعاء الغرب ليطالب بحماية مصالحه الخاصة “. على أي حال، هذه النتيجة يمكنها أن تكون مقدمة لنتيجة أخرى” سلمية ” و عقلانية و عادلة. يمكننا أن نستخدم السؤال التالي كنقطة انطلاق: “كيف ينبغي حماية مصالح الغرب؟” هكذا كانت إجابتي؛ أي أنه بدلا من استخدام لغة “صدام الحضارات”، يمكننا أن نختار و نرعى “توازن المصالح.” لديكم مصالح تهمنا، و لدينا مصالح تهمكم. بالتالي يحتاج كل منا لتحديد التوازن بين احتياجاتنا و احتياجاتكم. أنتم ستستفيدون، و نحن كذلك. و في هذه الحالة، فإن الاستفادة تكون مضاعفة؛ فنحن سنستفيد من خبرة الغرب في قطاع صناعة النفط.
ليس ذلك فحسب، بل أيضا في مجال تطبيق الديمقراطية، و يتضمن ذلك: احترام حقوق الإنسان و التسامح و العدالة ،الخ. وفيما يتعلق بالغرب، فإنه سيستفيد؛ ليس فقط من نفطنا و أسواقنا، بل سيكسب ثقتنا و احترامنا أيضاً. هكذا أوضحت جلياً أن نفطنا لا قيمة له دون الغرب، ثم أضفت: خذوا هذا النفط لكن في الوقت نفسه ساعدوا شركائكم. ساعدوا تلك البلدان التي لديها هذا النفط، و تلك البلدان الأخرى التي تفتقر إليه، لكي تتطور و تصل إلى درجة استهلاك السلع الأوروبية و الغربية، بحيث يؤدي كل ذلك إلى حدوث تقارب حقيقي. من بعد، ثمة حاجة لتثقيف الشعوب، و مساعدتها على فتح عقلياتها، و تشجيع الليبرالية و العقلانية و ما إلى ذلك. إن ما يقوم به بوش الآن، هو و المحافظون الموجودون– حالياً – في الإدارة الأمريكية، لهو العكس مما سبق تماما.
حالياَ السياسة الغربية، وبالأخص سياسة أمريكا، يستحوذ عليها منطق الحرب. انظري معي إلى [هذه السياسة في] أفغانستان و كوريا و العراق و فلسطين و في لبنان اليوم و في ليبيا من قبل. السياسة الأمريكية هي سياسة تتشكل بمنطق الحرب، كما أنها أيضاً سياسة رعاية مصالح، بالتالي فإن رد الفعل سيكون دائما على غرار ما يحدث مع حزب الله أو تنظيم القاعدة. في هذه الأيام كثيرا ما يطلب منا حضور مؤتمرات لمناقشة الديموقراطية في العالم العربي. يبدو لي أن الهدف الرئيسي – و حسب وجهة نظرك – هو احتواء المتطرفين وأن [تحقيق] هذا الأمر ممكن من خلال التغييرات التي تحدثت عنها.
هل ثمة أيضا معضلات هيكلية فيما يخص العلاقة بين الثقافة الإسلامية و الديمقراطية الليبرالية؟
لا. الدين هو تأويل لنصوص. النصوص لا تتطق بحد ذاتها، بل تُستنطق. و عندما يعيش المرء وضعا صراعيا مثل الوضع الحالي؛ فإن تأويله للنصوص المقدسة سينطبع بالطابع الصراعي. أما لو عشنا في بيئة سلمية في المستقبل، و في سياق تعاون بناء؛ فإن تأويل النصوص المقدسة سيغير طابعه، فالنصوص الدينية متعددة بحكم طبيعتها. أحدهم قال ذات مرة عن النصوص الدينية:
“بداخلها يمكنك أن تجد أي شيء تبحث عنه، حتى الشيطان.” و النصوص المقدسة يمكن تأويلها، و في كل مرة “يتغير” العالم، يصبح من الضروري استخراج معنى جديد منها. مع ذلك، فبالنظر إلى أننا (المسلمين و سكان العالم الثالث) مواجهون دائما بهيمنة سلطة أكثرمنا قوة، فمن المؤكد أننا سنلجأ إلى التعبير الديني مستخدمين الدلالات الدفاعية فيه؛مثل: نحن ندافع عن ديننا.. ندافع عن بلدنا.. ندافع عن الله.
على أي حال، عندما يتغير هذا الوضع؛ و تستبدل الهيمنة بالسلام من خلال توازن المصالح، “سنجد” في النصوص آلاف الآيات التي تأمر المؤمنين بالتعاون، و العمل مع الآخرين، و فعل الخير، و المسامحة. كل هذا موجود في الأديان.
إذن لم لا زالت الأديان موجودة حتى الآن؟
لأن النصوص دائما جاهزة لأن تأول في إطار سياق معين، كما هي أيضا جاهزة لكي تأول في إطار سياق آخر مناقض.
إن هذا المنظور لمشترك بين عدة فلاسفة من أبناء الثقافة العربية؛ مثل: نصر أبو زيد أو الإيراني عبد الكريم سروش.
و غيرهم كثر أيضا. و هو ينطبق على الإسلام و اليهودية و المسيحية. في تاريخ المسيحية كانت هناك أوقات أدى الدين فيها دورا تقدمياً؛ أي من أجل الانسانية و الشعوب، لكن من ناحية أخرى فقد كانت هناك أيضا أوقات أدى فيها الدين دوراً رجعياً. الحال نفسه ينطبق على الإسلام.
حول هذا الموضوع، هل هناك فوارق مهمة تفصل بين مختلف الاتجاهات الفلسفية الفكرية الإسلامية ؟
بالطبع هناك اتجاهات فلسفية فكرية مختلفة، لكن هناك فرق أساسي بين المسيحية و الإسلام. في المسيحية التأويل تقوده الكنيسة و يسترشد بها، و قد يتأتى من داخلها أو خارجها، لكن هي دائما موجودة باعتبارها المؤسسة التي تنسب لنفسها حق احتكار التعاليم باسم ديانتها. في الإسلام، بدلا من ذلك، فليس هناك كنيسة. أي فرد يأنس في نفسه الكفاءة على قراءة و تفسير النصوص المقدسة، يمكنه القيام بذلك. هذا هي سمة الإسلام الليبرالية التي تسمح لأي شخص متعلم قادر على فهم النصوص أن يعبر عن رأيه الخاص فيها، و يسجل ملاحظاته الخاصة حولها. وهذا ما يفسر عدم وجود رجال دين [بالمعنى الكهنوتي المسيحي] في المذهب السني. أما في المذهب الشيعي فتختلف الأمور؛حيث يوجد رجل دين؛ أعني الإمام و هو منصب أقرب – بطريقة من الطرق – إلى منصب البابا.
سمعت هذه الأشياء من قبل، في شكل نظريات، لكنني يتملكني انطباع أن السياسة، أو بالأحرى المجموعة المتكاملة من التراث و السلطة و أحكام الشريعة، في نهاية المطاف كان لها – دائما – تأثير كبير في العالم الحقيقي، بل و تمارس نوعا من الهيمنة المنظمة.
إنه الأمر نفسه مراراً و تكراراً، كما شرحت سابقا.
عندما يظهر مصلح عظيم، مثل المصري الشهير: [الإمام] محمد عبده (1849-1905)، فإن مواقفه الليبرالية يتردد صداها بقوة في العالم الإسلامي بأسره. أما التدخل الاستعماري و الهيمنة الامبريالية فلهما الأثر العكسي. عندما تعاني الشعوب بسبب التدخل الأجنبي، فإن الإصلاح، سواءاً كان دينياً أو ذا طبيعة مختلفة، سوف يتسم بالوطنية. لا ييًطبّق الإصلاح في ظل الاحتلال. بل في هذه الوضعية، يصبح الدين مسألة هوية؛ و يزداد الاستلهام من الأمجاد التليدة، و بالتالي [يزداد التأليب] ضد “الآخر”؛ أي ضد الغرب تحديداً.
لقد استشهدتِ بنصر أبو زيد، فما الذي فعله بالتحديد؟
لقد حاول أن يسائل مفهوم “النص”، بمعنى القرآن. في الواقع، هو – فقط – دعم وجهات نظر كانت معروفة في كتب مفسري القرآن، و التي عرفت باسم “علوم القرآن”، و هي مجموعة معارف و علوم تكرست في تفسير القرآن. لقد ناقش علماؤنا الأوائل – بحرية – القضايا المطروحة في هذا المجال، و مارسوا حقهم في “الاجتهاد”؛ بمعني أنهم بذلوا الجهد – أي أعملوا عقولهم – ليس لفهمه و حسب بل أيضا لملء فراغات النص الديني بحيث يتفق معناه مع العقل و معطيات التجربة المادية و الواقع الاجتماعي.
إذا استخدمنا هذا السياق العلمي، [نجد أن قول نصر] أبو زيد لم يتجاوز ما “قيل بالفعل”. و مع ذلك، فإنه عندما اتخذ موقفا ضد المتطرفين (و قد فعل ذلك بنصه المثير للجدل و الذي صار مقدمة لكتابه)، هاجموه قائلين: “لقد تهجمت على القرآن بالادعاء أنه غير مطلق” عن طريق مقارنتك نصوصه بالوقائع التاريخية. هم يدركون جيدا أن أحد الشروط اللازمة لتفسير القرآن الكريم هو معرفة ما ذكره العلماء المتخصصين في “علوم القرآن”، و بالتحديد ما يتعلق بـ “أسباب” النزول الآيات القرآنية (علماً أن القرآن نزل بالوحي منجماً و متفاعلاً مع ظروف معروفة، و استمر كذلك لأكثر من عشرين عاما). في رأيي أن المشكلة، في حالات مثل هذه، تتعلق باستراتيجية الخطاب [المستعملة].
أتفهم ذلك. لكن منذ ما قبل الاستعمار، أي منذ قرون، و لما لم يكن هناك أي احتلال، كان السياسيون في العالم العربي شديدي البطش و الاستبداد، و كانوا يسيئون استغلال الدين.
في القرن الرابع عشر، كان ابن خلدون قد سبق و قال:
“أولئك الذين يرغبون في أن يعملوا و يرغبون أن ينموا، فإن عليهم أن يغادروا البلاد.”
و هذا ما حدث تماما و من قبل مجيء الاستعمار.
أعتقد أن ابن خلدون عبر عن نفسه بهذه الطريقة ليشير إلى وضع معين، و لم يجعل هذا المعنى من أحد تعاليمه. لكن مع ذلك، فهناك سؤال بارز دائماً ما أطرحه حول هذه النقطة. لقد أشرتِ إلى وضع عام. أما سؤالك فكان يدور حول سبب دخول الحضارة الإسلامية مرحلة انحطاط و جمود.
ما السبب؟
لا أعتقد أن أحدا يستطيع الإجابة على هذا النوع من الأسئلة بالإشارة إلى سبب واحد أو حتى إلى عدد من الأسباب. إنها بالفعل ظواهر عصية على التحديد. يمكن للمرء أن يسأل نفس السؤال بالنسبة إلى الحضارة اليونانية: لماذا مباشرة بعد أرسطو سقطت في فترة انحطاط مشابهة؟ لماذا عانت الحضارة الفرعونية المصرية من نفس المصير؟ لماذا انجرفت الحضارة الرومانية، روما العظمى، هي الأخرى نحو عصور انحطاط؟ إنها ظاهرة تاريخية لا يمكن تفسيرها بسبب واحد أو آخر. ليس هذا ممكناً. إنها أمر معقد.
بالتأكيد الحروب لعبت دائماً دورا هاماً جداً. المؤرخ الإنجليزي توينبي، كان قد درس تاريخ البشرية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، و توصل إلى الاستنتاج التالي: الحرب هي السبب الأول لانحطاط الحضارات. و قال إن الحرب هي سرطان الحضارة الغربية. مثلما يحدث في حالة المرض بالسرطان، فإن المريض لا يتكهن بالانتكاس من البداية، لا يتكهن أحد أن الحرب هي مسار ينتهي بالانحطاط. الانحطاط يبدأ تماماً مثل مرض السرطان، ثم ينتشر بعد ذلك في عموم الجسم، و في النهاية لا يعود ممكناً العثور على حل. الحرب الشعواء تندلع من مستصغر الشرر. ما هي الأسباب التي تحفز عملية التدهور الاقتصادي و الاجتماعي الخ؟ لم حدثت النهضة الأوروبية خلال نفس الفترة؟ هذه أمور لا يمكن تفسيرها بسبب واحد فقط أو آخر. إنه تاريخ البشرية، و فلسفة التاريخ، تماما كالذي حدث للحضارة اليونانية وغيرها من الحضارات. قطعاً هناك عوامل أخرى، كما وجدت أيضا العوامل الطبيعية التي ساهمت في الانحطاط؛ مثل: الزلازل أو الفيضانات. و هناك موجات من القبائل الغازية، و الرعاع الخيالة القادمين من مضاربهم النائية غير المتحضرة ليفرضوا [على الأمم الأخرى] أنماط حيواتهم القبلية. ثم هناك التقاليد و الأعراف القبلية التي لم يتم التغلب عليها في بلداننا حتى الآن. في أوروبا هذه التقاليد و الأعراف تم التغلب عليها بـ[ثقافة] التصنيع، أما نحن فلم نكن نملكها في بلداننا. ليست لدينا صناعات [مكتملة]، عليه فأريافنا لم يطرأ عليها تغيير، و ظلت العادات والأعراف القبلية لدينا لها نفس السطوة حتى اليوم.
في تاريخ الفلسفة الغربية يمكن للمرء أن يحدد بوضوح لحظات استطاع فيها الفكر أن ينفتح – و ببعد جماعي – على الثقافات الأخرى. على سبيل المثال في فترة العصور الوسطى تمثّلت لحظات هامة في أفراد مثل: آبيلارد. و فترة التنوير تمثلت في نيكولا كوسان و مونتين و العديد من مفكرين، و اليوم تتمثل في تشارلز تايلور. إنه فكر قادر على بناء جسور تجاه الآخرين، و على احترام الثقافات الأخرى بصورة مساوية من خلال منظور معرفي.
لذا فإن السؤال هو: في أي لحظات في تاريخها مرت الثقافة العربية بمثل هذا الانفتاح في الماضي و في عصرنا الحالي؟
لقد كانت قمة رقي الحضارة الإسلامية في القرون العاشر و الحادي عشر و الثاني عشر. خلال تلك القرون تطور انفتاح لا يضاهى في ديار الإسلام. كما شرحت في كتابي الذي عنوانه: (تكوين العقل العربي)[1] فإن العرب بدأوا بغزو أراضي الإمبراطوريتين الفارسية و البيزنطية، وانتهوا بالإرث الثقافي لهاتين الإمبراطوريتين غازياً لعقولهم. لقد كانت الحضارة العربية الإسلامية منفتحة لجميع المدارس الفكرية، و كان هذا الانفتاح سمتها المميزة. بل و صار حقيقة ماثلة في الأفكار متعددة الأبعاد للغزالي وابن سنان وابن رشد و غيرهم.
بل و بعد أولئك العلماء ظهر في القرن الرابع عشر أبو إسحاق بن موسى الشاطبي، و هو فقيه وضع قواعد جديدة لإعادة ترتيب أحكام الشريعة، ليس على أساس القياس (الحكم على المستجدات الأحدث بمقارنتها بمماثلتها في الأحكام السابقة الواردة في النصوص أو في أقوال الفقهاء السابقين)، بل على أساس المقاصد، و بالتالي على أساس المصلحة المشتركة للبشرية. و ذكر [الشاطبي] أن هذه المصلحة – وفقا لما عبر عنه كل علماء الأديان السماوية الثلاثة – تتكون من خمسة مقاصد هم: حفظ النفس، و حفظ العقل، و حفظ النسل، و حفظ المال، و حفظ الدين.
هذه المقاصد الخمسة يجب أن تكون الأركان الخمسة لكل تأويلات النصوص الدينية، و هي التي تلهم [المعاملات] الدينية بمجملها، و كل التصورات الذهنية، و كل القانون ما كان منه جنائياً أو مدنياً. بذلك اُعتبر [ما جاء به الشاطبي] تجديداً بلا شك. بل إن قضية الإصلاح الديني في الإسلام طرحت قبل الشاطبي بوقت طويل؛ ففي القرن الثاني الهجري، ورد في الحديث النبوي:
” إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.”
من الواضح جدا إذن أن هناك ضرورة للإصلاح، لكن الإصلاح يمكن أن يمضي إما بالتوجه إلى الأمام أو بالتوجه إلى الخلف. فإذا وجد مجتمع ما أنه قد فرض عليه أن يخوض معركة ضد غزاة أجانب من النوع الاستعماري، فإن الإصلاح سيمضي بالتوجه إلى الخلف باحثا عن السند و الأمل في ماضيه. و هذا هو حال مدرسة الفكر السلفي.
هل تعتقد أن الإسلام يضع عراقيل ذات طابع ديني أو آيديولوجي أو عقائدي أمام مفهوم المساواة في المواطنة تجاه الأشخاص المنتمين إلى ثقافات و أديان أخرى؟
كلا. الأيدولوجيا سواءاً كانت ذات طابع ديني أو ذات طابع آخر، تؤدي دورها في الحالات التي بها ظروف اجتماعية و ثقافية و اقتصادية مسلّم بها. لذا؛ الأيديولوجيات لا تخلق دول. ابن خلدون قال أنه من أجل إنشاء دولة فلا بد من وجود عصبية (أي وجود تحالفات قبلية)، و وجود قوى اجتماعية و مادية من صنيعة عصرها.
ثم من بعد ذلك تأتي الأيديولوجيا باعتبارها قوة تعبوية. جوهر الأيديولوجيا يتجلى في تعبئة الناس و الجماعات عن طريق تصوير مستقبل منشود على شكل “واقع” مأمول- أي خلق واقع مأمول يحرض على العمل من أجله. هذا هو الدور الثوري للأيديولوجيا، سواء كانت دينية أو ماركسية أو ذات أي طابع آخر، لكن الأيديولوجيا لا تخلق التاريخ. الأيديولوجيا هي تمظهر- تجلِّ لعوامل مادية في مخيلة الأشخاص. لا يحتاج المرء إلى أن يكون ماركسيا حتى يقر بالدور الذي تلعبه الأيديولوجيا. إنها حقيقة اجتماعية و ثقافية يمكن أن نراها في المجتمع الصناعي الذي تحدث عنه ماركس، و في المجتمع القبلي لبذي تحدث عنه ابن خلدون. من دون واقع “قد نضج” للتغيير، فلا يمكن أن يكون هناك أي أيديولوجية تعبوية.
المصدر الـ حوار مع محمد عابد الجابري
ترجم حوار مع محمد عابد الجابري من الإيطالية إلى الإنجليزية: فرانشيسكا سيمونز.
نشرت هذ الـ حوار مع محمد عابد الجابري في مجلة ريست الإيطالية في خريف 2006.