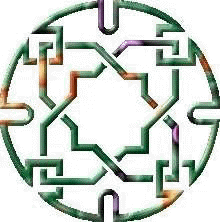
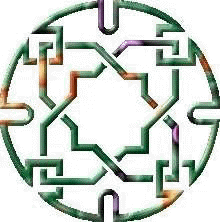



جريدة البيان الإماراتية
هاشم صالح
16 نوفمبر 2007
محمد الوقيدي هو أحد المختصين العرب القلائل بفلسفة العلوم أو ما يدعى بالإبستمولوجيا. وقد صدرت له عدة كتب عن هذا الموضوع. وفي كتاباته العديدة يتناول عدة موضوعات متقاربة ومختلفة من مثل: الفلسفة والحوار، شروط الحوار الفلسفي في المغرب، الفكر الفلسفي في المغرب بين الإتباع والتأثر والتجديد، جرأة الموقف الفلسفي، الخ...
فيما يخص أهمية الحوار يكتب وقيدي عدة صفحات مهمة. ونجد أنفسنا متفقين معه عندما يقول بأن وجود الفلسفة مرتبط بالحوار الفكري الشامل، وأن الفلسفة لا يمكن أن توجد في مجتمع خال من الحرية الفكرية.
إن د. وقيدي يميل إلى المطابقة بين الفلسفة ـ والإبستمولوجيا أو فلسفة العلوم. ولكننا نعلم أن هناك فلسفات كبرى ظهرت على هامش العلم أو بعيداً عنه. إنها فلسفات مرتبطة بالعلوم الإنسانية أو بالثورات الأخلاقية والروحية. نضرب عليها مثلاً فلسفة جان جاك روسو مثلاً، أو حتى كارل ماركس. مهما يكن من أمر فإن الفلسفة هي في حالة حوار دائم، سواء مع الفكر المعاصر لها أو السابق لها.
بهذا المعنى فإن ديكارت كان يحاور أرسطو حتى وهو ينهض ضده أو يحدث القطيعة معه. وقل الأمر ذاته عن لوك، وهيوم، وكانط، وهوسيرل، وباشلار، ومحمد عزيز الحبابي... فهؤلاء أيضاً حاوروا ديكارت مؤسس الفلسفة الحديثة بشكل صريح أو ضمني على مدار أعمالهم وبحوثهم.
ويقسِّم المؤلف المجالات الفلسفية المطروحة في المغرب إلى عدة أنواع، نذكر من بينها الفلسفة الإسلامية ومذاهبها وتاريخها والتراث العربي ـ الإسلامي بصفة عامة. وهناك أيضاً الفكر العربي المعاصر، ثم الفلسفة الأوروبية المعاصرة باتجاهاتها المختلفة ذات النزعة الإنسانية أو التي تنتقد هذه النزعة. وهناك أيضاً مؤلفات تتعلق بالفكر المغربي في القرن التاسع عشر وبداية هذا القرن.
وهناك مؤلفات تتعلق بالإبستمولوجيا وتاريخ العلوم، والمنطق، الخ... ثم يدعو إلى إقامة حوار حقيقي بين فلاسفة كل هذه الاتجاهات. ويتحدث الدكتور الوقيدي بعدئذ عن مدى إبداعية أو تبعية الفلاسفة المغاربة المعاصرين.
ويقول أن ما نلاحظه هو أن الفكر الفلسفي في المغرب مشدود بكيفية متوترة إلى مصدرين أساسيين هما: التراث الفلسفي الإسلامي، والتراث الفلسفي الأوروبي بشقيه الحديث والمعاصر. ولكن هذا الكلام ينطبق على معظم فلاسفة العرب إن لم يكن كلهم. الفرق الوحيد هو أن المرجعية الأجنبية لفلاسفة المغرب هي فرنسية أساساً، في حين أنها إنجليزية أو فرنسية بدرجة أقل بالنسبة للمشارقة. ثم يستعرض المؤلف فلاسفة المغرب المعاصرين ومرجعياتهم مبتدئاً بالحبابي.
ويقول عنه بأنه متأثر بفلاسفة الإسلام الكبار كالفارابي وابن رشد ولكنه تأثر أيضاً بمذهب فلسفي فرنسي معاصر هو: المذهب الشخصاني. وبالتالي فهو تراثي وحديث، أو أصيل ومعاصر في آن. ولم ينس الحبابي جذوره عندما تأثر بالفلسفة الشخصانية ذات الطابع الإيماني المسيحي على طريقة ايمانويل مونييه. فبدلاً من مفهوم الحرية الميتافيزيقي راح يتحدث عن مفهوم الحرية بالمعنى الواقعي للكلمة. وذلك لأن بلاده كانت واقعة آنذاك تحت وطأة الاستعمار الفرنسي.
يقول الوقيدي موضحاً: لم يغفل الحبابي أنه مفكر عربي مسلم كان ينتمي إلى ما دعي في زمن تفكيره بالعالم الثالث. ولذلك عالج مفهوم الشخص وقيمته في ضوء معالجة مشكلات الثقافة الوطنية في بلاد خضعت للهيمنة الاستعمارية.
وفي هذا الإطار انتقل أيضاً في أحد كتبه إلى الحديث عن الشخصانية الإسلامية وهذا تمايز آخر يفرقه عن الفرنسي «مونييه» الذي كان يتحدث عن الشخصانية المسيحية. وبالتالي فإن محمد عزيز الحبابي لم ينس هويته أو شخصيته أو أصالته عندما اعتنق مذهباً فلسفياً أوروبياً. وإنما عرف كيف يمزج بين الأصالة والمعاصرة، أو بين التراث والحداثة.
ثم ينتقل المؤلف للتحدث عن فيلسوف مغربي آخر هو: عبد الله العروي. فالعروي، على خلاف الحبابي، لم يختر الشخصانية ولا حتى الوجودية، وإنما اختار التاريخانية بل والماركسية (في مراحله الأولى على الأقل).
ولكنه عرف كيف يعرّب الماركسية أو يدمجها في التراث الفكري العربي المعاصر. وهذا يعني أنه لم يكن تابعاً مقلداً للغرب بقدر ما كان مجدداً في فهمه لهذه الفلسفة الغربية. وهذا هو التأثر الذكي، لا العبودي ولا الاستلابي.
يقول د. الوقيدي: هنا يلتقي المفكر العربي بالماركسية كما يلتقي بها المفكر الأوروبي. ولكن دواعي اللقاء وشروطه وغاياته ليست واحدة. ولهذا السبب يختلف فهم العروي للماركسية عن فهم التوسير مثلاً. فالفيلسوف الفرنسي يفهمها من خلال حاجيات المجتمع الفرنسي ومنظوره، في حين أن العروي يفهمها من خلال منظور المجتمع العربي أو المغربي أو العالم ثالثي.
وبعدئذ يتحدث د. الوقيدي عن مفكر آخر نال شهرة واسعة في العقدين الأخيرين ألا وهو: محمد عابد الجابري. ويقول: هنا أيضاً نجد أن التفكير الذي مارسه الجابري على قضايانا الفكرية والتربوية والفلسفية والتراثية يعتمد على عناصر منهجية يمكن ردها إلى أصول عربية - إسلامية، أو أوروبية - فرنسية: فصاحب «نقد العقل العربي» متأثر كثيراً بابن رشد، ولكنه في ذات الوقت متأثر بمرجعيات أوروبية كبرى من أمثال غاستون باشلار (وبخاصة في مفهومه عن القطيعة الإبستمولوجية).
وكذلك اعتمد على «لالاند» الفرنسي في تمييزه بين العقل المكوِّن والعقل المكوَّن، واستلهم أيضاً أعمال كانط، وبياجيه، وميشيل فوكو، الخ... وكل هذا لم يفصله عن تراثه العربي - الإسلامي، فظل وفياً لأصالته التاريخية على الرغم من استفادته من كل هذه المرجعيات الأوروبية.
ثم يتحدث د. محمد وقيدي عن وضع الفلسفة في مجتمعنا العربي - الإسلامي ماضياً وحاضراً ويقول بأن بعض المفكرين اعترضوا عليها من أمثال الغزالي وابن خلدون وغيرهما. وكان لهذه المواقف زمنها ومبرراتها وشروطها، ولكنها لا تزال ماثلة في زمننا لأن التيارات السلفية المنغلقة لا تزال تعتمد عليها لرفض الفلسفة. ثم ينبه إلى ضرورة استشعار القطيعة التي تفصل بيننا وبين فلاسفتنا القدماء كالكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد.
فظروفهم غير ظروفنا ومرجعياتهم غير مرجعياتنا وهمومهم غير همومنا ومصطلحاتهم غير مصطلحاتنا. والواقع أننا إذا لم نعِ مفهوم القطيعة الإبستمولوجية في التاريخ فلا يمكننا أن نتقدم إلى الأمام خطوة واحدة ولا أن نحلّ مشاكل الحاضر. سوف نظل أسرى الماضي ومسجونين فيه أو منغلقين عليه.
هذا لا يعني بالطبع أنه لا شيء يربطنا بمفكري الماضي أو أن دراستهم باطلة وغير مفيدة. على العكس. وإنما ينبغي أن نفهم المسافة التي تفصلنا عنهم من خلال دراستنا العلمية الدقيقة لهم، ومعرفة كيفية الانفصال والاتصال في آن معاً.
أحيانا يقارن الوقيدي بين وضع الفلسفة عندنا ووضعها في أوروبا في لحظة هوسيرل. وأعتقد أنه يضلّ الطريق هنا، فلا وجه للمقارنة. فهوسيرل يتحدث عن وضع الفلسفة الأوروبية عام 1929 ويشكو منه ومن ضعفه، ويدعو للعودة إلى لحظة ديكارت. ولكن هوسيرل يعرف أنه توجد بينه وبين ديكارت فلسفات كبرى هي: فلسفة كانط، فهيغل، فالمثالية الألمانية كلها.
وأما نحن فلا يوجد وراءنا أي تراث فلسفي طيلة عصور الانحطاط.وبالتالي فكيف يمكن أن نقارن بين أزمة الفلسفة عندنا (وهي ناتجة عن انعدام الفلسفة)، وأزمة الفلسفة في عهد هوسيرل (وهي ناتجة عن تخمة الفلسفة)؟ إن هوسيرل، على الرغم من شكواه، يرتكز على تراث كامل في الفلسفة، في حين أننا نرتكز نحن على فراغ، أو فراغ الفراغ.
وبالتالي فإني أدعو شخصياً إلى تأسيس الموقف الفلسفي عندنا عن طريق الإكثار من الترجمات لأمهات الكتب الفلسفية وشرحها والتعليق عليها. بهذه الطريقة وبها وحدها نستطيع أن نستدرك ما فات ونسدّ النقص المريع الذي نعاني منه حالياً. وبالتالي فإن حركة الترجمات الكبرى سوف تسبق مرحلة الإبداعات الفلسفية الكبرى في المجال العربي.
ولا يمكننا أن نبدع فلسفياً حالياً ما لم نحول لغتنا العربية إلى لغة فلسفية مجدداً، ونغذيها بالمصطلحات والتراكيب الفلسفية التي غابت عنها طيلة سبعة قرون (أي منذ سقوط ابن رشد وتعرضه للإهمال والنسيان).
وبالتالي فإن مشكلتنا تكمن في تأسيس الفلسفة من جديد لا في نقد تراثها غير الموجود أصلاً عندنا.
فلنكنْ متواضعين إذن ولنصبر ولنعمل كثيراً قبل أن يتشكَّل عندنا فكر فلسفي حديث في اللغة العربية وقبل أن يتراكم ويتراكم حتى يصبح تراثاً، وأما اللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو الألمانية فلم تنقطع عن التفلسف منذ لحظة ديكارت وحتى اليوم. وبالتالي فقد تشكل في هذه اللغات الأوروبية الحديثة تراث فلسفي طويل عريض أين نحن منه.