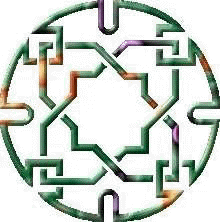
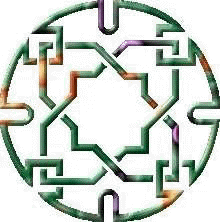



مجلة العربي الكويتية
1 ابريل 2004
سليمان إبراهيم العسكري

أمام التفجر المعرفي الهائل في المواقع المتقدمة من عالمنا, والتي أفرزتها ثورتا المعلومات والاتصالات, بات واضحًا أن هناك أزمة تعريب, ينادي بعض المخلصين بضرورة الإسراع في حلها, لكن هناك ضرورة لتأكيد أن هذه الأزمة, ما هي إلا فرع من (الأزمة الأم) للغة العربية ذاتها.
|
لغة يهون على بنيها أن يروا |
|
يوم القيامة قبل يوم وفاتها |
بهذا البيت من الشعر المهجري ختم الدكتور محمود فوزي المناوي كتابه الصادر حديثا عن مؤسسة الأهرام بالقاهرة, تحت عنوان: (أزمة التعريب), ومؤلف الكتاب أستاذ من أساتذة الطب الكبار في مصر والوطن العربي, وهو من المدافعين بشدة عن تعريب العلوم وتعريب التعليم, وقد أثار الكتاب ردود فعل واسعة بين مؤيد, ورافض, ومتردد. لكن الإجماع ظل معقودًا على جدية الكتاب وإخلاص صاحبه, وهو جانب ننضم إليه دون تردد, لكننا نظل متمسكين بحقنا في الاعتراض على ما ينبغي الاعتراض عليه, من زاوية رؤية مختلفة قليلاً أو كثيرًا, ومن زاوية الرؤية هذه ننظر إلى بيت الشعر الذي اختُتم به الكتاب, لنبدأ الاختلاف, أو الحوار, أو الإضافة, منحين جانبا مبالغات الشعر والشعراء, متسائلين: إذا كان صعبًا على العرب إلى هذا الحد رؤية لغتهم متوفاة, فهل يكون أقل صعوبة عليهم رؤية هذه اللغة عليلة, علة لم تبلغ حد الموت, لكنها أيضًا تفتقد حيوية الحياة?
الأزمة الأم
إن موت اللغة العربية أمر مستبعد في المستقبل المنظور, لأسباب يشير إليها الدكتور عبدالسلام المِسدِّي بمنطق تاريخي, إذ يقول: (لأول مرة في تاريخ البشرية - على ما نعلمه من التاريخ الموثوق به - يُكتب للسان طبيعي أن يعمّر 17 قرنًا محتفظًا بمنظومته الصوتية والصرفية والنحوية, فيطوعها جميعًا ليواكب التطور الحتمي في الدلالات دون أن يتزعزع النظام الثلاثي من داخله, بينما يشهد العلم في اللسانيات التاريخية والمقارنة أن القرون الأربعة كانت فيما مضى هي الحد الأقصى الذي يبدأ بعده التغيّر التدريجي لمكونات المنظومة اللغوية).
ويعضد رؤية الدكتور المسدي في استبعاد موت اللغة العربية, حتى على المستوى الدولي, شهادة من الوزن الثقيل لمفكر غير عربي, فقد أعلن الكاتب الإسباني (كاميلو جوزي سيلا) - الحائز على جائزة نوبل في الآداب عام 1989 - عن تنبؤاته المستقبلية وتقديراته الاستشرافية حول مصير اللغات الإنسانية بقوله: (إنه نتيجة لثورة الاتصالات سوف تنسحب أغلب اللغات من التعامل الدولي وتتقلص محليًا ولن يبقى من اللغات البشرية إلاّ أربع قادرة على الوجود العالمي والتداول الإنساني, وهي الإنجليزية والإسبانية والعربية والصينية).
واضح أن رأي (سيلا) مستند إلى ركائز لعل أهمها ضخامة الكتلة البشرية التي تستخدم هذه اللغة أو تلك بدرجة ما من التجانس. وأيًا كان الأمر فإننا نسلّم بعدم موت اللغة العربية, لكننا لا نستطيع التسليم بنفي مواتها المحتمل - إن استمر منحنى الهبوط على ما هو عليه من تسارع وتفاقم - والذي لا يختلف عليه مراقب موضوعي, هنا أو هناك, إلاّ في تقدير حجم هذا الاعتلال وتقييم خطورة أعراضه.
لا مراء في أن (أزمة التعريب) هي حقيقة واقعة, وخانقة, لكنها - بداهة - نتيجة لـ (أزمة أم) هي أزمة اللغة العربية ذاتها, وهما معًا - أزمة اللغة العربية وأزمة التعريب - نتاج أزمة عربية أشمل تتعلق بالتراجعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على مستوى الكيان العربي الجامع - دون أي ادعاءات قومية - فلأسباب عديدة, جغرافية, وثقافية, وتاريخية, واقتصادية, وبيئية, ثمة تأثير وتأثر شديدا الوضوح بين الأقطار العربية, وكأنها الأواني المستطرقة يلحق بعضها بعضًا في الهبوط أو الصعود, مهما كانت درجات الاختلاف.
وبتنحية الإطار الشامل للأزمة العربية العامة لأسباب عملية, مع عدم نسيانه. وبغية التركيز على موضوع أزمة العربية التي نراها (الأزمة الأم) لأزمة التعريب, نجد أنفسنا معنيين - في هذه المداخلة - لهذا الشهر - بأزمة لغتنا العربية. والحديث عن الأزمة, أي أزمة, في النطاق السوي, والذي ينبغي أن يكون سويا فيما نحن فيه, لا يعني جلد الذات أو البكاء على الأطلال, بل يعني محاولة تحديد مكونات معادلة صعبة, وإعادة ترتيبها طموحًا إلى حلها أو استشراف حلها. وطبيعي في هذا السياق أن نعود بأسئلتنا إلى السؤال البدء فيما يتعلق بلغتنا العربية: (وهل هناك حقًا أزمة)? وفي صياغة أخرى: (وهل هي أزمة حقيقية)?!
للإجابة عن هذا السؤال ذي الصيغتين, ثمة مستويان, أولهما بديهي وانطباعي يشهد به العموم مما يتبدى على السطح, وثانيهما متخصص وباحث ومتعمق فيما هو تحت السطح.
الداء اللغوي وأعراضه
لنبدأ بالمستوى الأول, فنقول: نعم هناك أزمة, وأزمة حقيقية في حياة وحيوية وسلامة لغتنا العربية, ومظاهرها:
أما على المستوى الأعمق, فالقراءة المتقصية والباحثة تؤكد وجود هذه الأزمة, بل إن أحد أكثر المهتمين بها, عبر اختصاصه وخبرته المعروفة في تكنولوجيا المعلومات, وهو الدكتور نبيل علي, يقول عن هذه الأزمة: (لا يخفى على أحد أن العالم العربي يعيش أزمة لغوية طاحنة على جميع الأصعدة: تنظيرا وتعليما, نحوًا ومعجمًا, استخدامًا وتوثيقًا, إبداعًا ونقدًا, وجاءت تكنولوجيا المعلومات لتضيف إلى خليط هذه الأزمة عنصرًا تكنولوجيا متعلقًا بمعالجة اللغة العربية آليا بواسطة الكمبيوتر). وفي صياغة مكثفة أشار خبير تكنولوجيا المعلومات العربي إلى أزمة العربية بنقاط وردت في تقرير التنمية الإنسانية العربي الثاني هي:
العربة والحصان
أزمة اللغة العربية حقيقية, وطاحنة, ونكرر أنها تعكس أزمة الوجود العربي الأعمّ والأشمل, وتفرز أزمات تالية تكثّف وتسرّع من تفاقمها كأزمة أم, وأوضح الأمثلة على ذلك هو أزمة التعريب التي في استمرارها إفقار للغة الأم نفسها, إذ لم تعد هناك لغة في قريتنا الكونية هذه - كوكب الأرض - تستطيع أن تنمو بمعزل عن نمو المعرفة المتفجّرة بتسارع مدهش في الأجزاء المتقدمة من العالم. ولن ينجينا الاعتماد على لغة أجنبية مثل الإنجليزية التي يتكاثر التعليم بها, وينمو كالفطر على امتداد ساحة عالمنا العربي ظنّا بأنها مفتاح الولوج إلى المعرفة العالمية المتطورة. فإضافة لاختلال التوازن الثقافي لطلاب المراحل الأولى, الذين يعيشون في واقع ولا يتحدثون في مدارسهم بلغته, فإن لهذه الازدواجية أضرارها على لغة الواقع المعيش, أي العربية, واللغة في المدرسة - ولتكن الإنجليزية, ستظل مليئة بالثقوب, فيما لا تتطور اللغة الأم للصغار واليافعين, في مرحلة يتلازم فيها النمو الجسدي والنفسي مع النمو اللغوي. وثمة ملحوظة شديدة الأهمية في هذا الشأن تؤكدها الدراسات الحديثة, إذ يسود الاعتقاد الآن, خلافًا لما كان سائدًا فيما مضى, بأن اللغة الأم أساسية في تعليم اللغات الأجنبية, فاللغة الأم هي الأساس أو منصة الانطلاق إلى آفاق ثقافية مغايرة.
لكن هذه اللغة في أزمة, فكيف يكون الخروج منها?
من الأفضل, والأنفع, ألا نضع العربة أمام الحصان, ما دمنا نبحث عن مخرج من الأزمة تلك, ومن ثم سيكون مستهجنا القول إن حل أزمة اللغة سيكون عملية داخلة في سياق حل الأزمة الحضارية العربية الشاملة, سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا, فهذا القول لا يعني إلا إرجاء الحركة التي تعكس عدم الرغبة في الخروج من أي مأزق, لهذا ينبغي أن يكون العكس هو الصحيح, أي التعويل على حل أزمة الوجود العربي العامة بحلحلة الأزمات الجزئية داخلها, كل في مجاله وبشكل عملي, ومن هنا أتصوّر أن محاولة حل أزمة اللغة العربية ستؤدي بالضرورة إلى الإسهام في حل أزمة الوجود العربي العامة, وتيسير حل الأزمات التابعة أو المصاحبة, مثل أزمة التعريب, التي ينبغي أيضًا عدم إرجائها لحين الانتهاء, أو تصوّر الانتهاء, من حل (الأزمة الأم), أزمة اللغة العربية. وقد تكون الخطوة الأولى في تمهيد سبيل الحل, أو الحلول الممكنة, هي تنحية توجهات من التفكير لم تجد نفعًا, ولنفعل ذلك في إطار الإصلاح اللغوي نقول نعم لما هو منطقي ودافع ونافع, وننبذ ما فيه مبالغة, سواء شعرية أو وجدانية, ونظل متسلحين بيقظة ناقدة, ورفض لتقديس ما ليس مقدسًا من اجتهادات البشر بيننا أو قبلنا.
الكتابة والنحو والصرف
لقد جرت محاولات عدة لتطوير اللغة العربية بمنطق تيسيرها, إدراكًا بوجود صعوبات في تعلّمها وإتقانها من قبل الجمهور العام, مقارنة بلغات أخرى - أشهرها الإنجليزية كمثال واضح - فعلى مستوى الكتابة وتشكيل الأحرف نجد في الإنجليزية ستة وعشرين حرفًا لها اثنان وخمسون شكلاً ما بين الأحرف الصغيرة small والكبيرة capital. (ونحن نتحدث هنا عن الكتابة المعيارية سواء على الآلة الكاتبة أو بالكمبيوتر). أما اللغة العربية فإن أشكال كتابة حروفها الثمانية والعشرين تصل إلى 84 شكلاً, إذ إن هناك شكلاً للحرف في أول الكلمة وآخر في وسطها وثالثا في آخرها, ناهيك بأشكال إضافية تنشئها فنون الخط العربي المختلفة. أما منطق الإملاء في مسألة كالهمزة, فهو مما لا إجماع عليه حتى الآن. وفي إطار التطوير/التيسير اقترح أحد المجمعيين كتابة الأحرف العربية بشكل واحد أيّا كان موقع الحرف في الكلمة بشكل يقارب الخط المغربي, ولم يتجاوز الاقتراح حدود الصفحات التي اشتملت عليه ولم يلق اهتمامًا واسعًا من المعنيين بأمر العربية.
على مستوى النحو والصرف قُدّمت اقتراحات عدة للتطوير/التيسير, كان أشهرها يدور حول مسألة إعراب الأعداد - التي يحار فيها ويخطئ كثير من المثقفين والكتّاب العرب حتى الآن - ورأى البعض أن يقتصر الإعراب على اعتماد شكل واحد للأعداد أيّا كان موقعها من التذكير والتأثيث, كما في العاميات العربية الشائعة. أما عن تصريف الأفعال, فقد رئي اعتماد القياس وسيلة للاشتقاق. وأمام صعوبات القراءة, دون لحن, اقتُرحت القراءة بتسكين أواخر الحروف للإفلات من أخطاء الإعراب.
تلاشت كل هذه الاقتراحات مثل دخان في الهواء, ربما لعدم تلاؤمها مع الثقل التاريخي للغة العربية, وربما لأنها كانت (ثورية) أكثر مما يحتمله اللغويون المحافظون, وعلى الأرجح لأن اللغة العربية حتى زمن تقديم هذه الاقتراحات - والتي مضى على معظمها ما يقارب نصف القرن - لم تجأر بالشكوى من أزمة على الألسنة أو على أسنة الأقلام, إذ كانت الفصحى تمضي صحيحة إلى حد كبير لدى المتعلمين - تبعا لمستوى تعليمهم - وكان تعليم العربية نفسه يلقى نجاحًا برغم تقليدية المحتوى وتقليدية أساليب التدريس.
فماذا حدث لتصير العربية - الآن - في أزمة?
لنقل إنه التدهور العام الذي أفرخ جيلاً من المتعلمين يتخرجون في المدارس والمعاهد والجامعات غير مجيدين للمعارف التي حصلوا - أو كان ينبغي أن يحصلوا عليها ومنها اللغة العربية - وهؤلاء عندما تناط بهم مهمة تدريس غيرهم يؤدون المهمة بغير كفاءة ولا كفاية, فينشأ جيل أكثر ضعفًا لغويا مما سبقه, وبانتشار هذا الجيل في وسائل الإعلام والصحافة والتدريس تصير الأزمة واضحة وجلية.
أدوات ومفاهيم جديدة
ولو قلنا بذلك سببًا وحيدًا للأزمة اللغوية التي نحن بصددها, لكان علينا أن ننتظر نهوضًا عربيًا عامًا لينصلح حال التعليم من الجذور إلى الفروع وينصلح معه حال اللغة العربية. وهو أمر يضع مسألة الخروج من أزمة اللغة العربية في كف المجهول ولا يعني إلا الإرجاء, رفعًا للعتاب وإراحة للرءوس, بينما الأزمة تزداد إحكامًا والتدهور يتفاقم.
أما من سبيل, أو سبل أخرى? إنه تساؤل طرحه غيرنا على أنفسهم, ولابد أن مستخدمي الإنجليزية مع بروز (الإنترنت) طرحوا على أنفسهم السؤال, وكان التطوير/التيسير أن تقتصر الأحرف المستخدمة في عناوين البريد الإلكتروني وعناوين المواقع على الأحرف الصغيرة small وجمّلوا هذا الحال بالقول إنه يجعل الحديث خاليًا من الصراخ, وأقرب إلى الهمس في قرية كونية تلفها تلك الشبكة المعلوماتية, العابرة لكل الحدود الجغرافية والسياسية والعرقية بين البشر.
وفي موقع عملي وعصري آخر, وهو استخدام الهواتف المتنقلة في الرسائل النصّية messages, تم اعتماد اختصارات تلبي مساحة الشاشات الصغيرة وتتوافق مع اقتصادات المستخدمين لهذه الوسيلة العصرية في الاتصالات.
مثل هذه الممارسة لتطوير اللغة, في إطار التيسير, قد تكون مطلوبة ومقبولة في ثنايا الحياة المعيشية اليومية الدارجة, لكن تظل اللغة العربية الفصحى في الإطار المعرفي الأعلى والأعم في حاجة لاجتهادات أخرى جديدة وجادّة, وهذا ما يلمحه أيضا الدكتور نبيل علي محرر الجزء الخاص باللغة العربية, ومجتمع المعرفة في التقرير الثاني للتنمية الإنسانية العربية إذ يقول: (إن تراث الماضي, وفكر الحاضر, ومعرفة المستقبل تؤكد الحاجة الماسّة إلى تجاوز راهن الخطاب اللغوي العربي الذي ساده اللغويون والتربويون, ويتطلب ذلك نظرة أشمل وأعمق لمنظومة اللغة العربية, سواء بالنسبة لعناصرها الداخلية شديدة التداخل, أو علاقاتها الخارجية شديدة الأهمية التي تربط المنظومة اللغوية بالمنظومات المجتمعية الأخرى).
هذا المنطق المؤسس على معطيات جديدة في حقول المعرفة, المتداخلة والمترابطة, ليس مجرد مخطط يصلح لاقتراح سبيل للخروج من (الأزمة الأم) فيما نتحدث عنه, أي أزمة اللغة العربية, بل هو صالح أيضا لاقتراح سبل جديدة للخروج من أزمات مختلفة, فالمعارف المتشابكة وتقنيات ثورة المعلومات, وفرق البحث متعددة الاختصاصات, والاشتغال على أهداف عملية, هذه كلها صارت سمة من سمات حل الأزمات في العالم المتقدم.
في مسعى حل أزمة العربية, علينا أن نراجع ما صار في مقام الثوابت عن هذه اللغة, مثل قول ابن خلدون في المقدمة (اللغة هي التي تترجم ما في ضمائرنا من معان), وكأننا - حتى الضمائر - مجرد ظاهرة لغوية, فثمة ترجمات أخرى للضمير تتمثل في العمل والسعي والسلوك. ونراجع مقولة رددها أمين الخولي: (إن آفات حياتنا في جمهرتها تعود إلى علل لغوية, تصدع الوحدة, وتحرم الدقة, وتبدد الجهد, وتعوق تسامي الروح والعقل والقلب), فالعلل اللغوية ليست سببا وحيدًا لكل آفات حياتنا, إذ من الأرجح أنها نتيجة مترتبة على إصابة حياتنا بهذه الآفات.
ونضيف إلى مراجعاتنا أنماطًا جديدة - وإن بدت صادمة - من التفكير في اللغة مثل ما ذهب إليه جيرس كامبل في كتابه الإنسان النحوي (Grammatical Man), إذ يقول: (لابد من إعادة النظر في المفهوم السائد القائل إن اللغة مرآة العقل, فربما يكون للعقل مرايا أخرى تسبق اللغة, وتؤازرها, وتنسخها, وتحيل إليها).
اللغة التي نتحدث عنها هي وسيلة من وسائل الاتصال والتواصل البشريين, تمر عبر حقول جمالية, ووجدانية, وعملية ونفعية, ومعرفية, وغير ذلك كثير من الأنشطة الذهنية للإنسان, أما لغة المقدس فإنها تظل في رحاب مختلف نحتفظ له بكل الإجلال والقداسة.
هذه اللغة, البشرية, الوسيلة, ليست غاية في ذاتها ولا بذاتها, ومع ذلك فإن أزمتها تعكس خطورة المأزق, وتلتف على نفسها لتصير أحد منابع هذا المأزق, ومن المؤكد أن الاجتهاد, والإصرار على التجدد, والموضوعية, والأخذ بمكتشفات العصر المعرفية والتقنية, تؤشر جميعها إلى اقتراحات بالمخارج, ولعل حل أزمة التعريب تكون إحدى السبل في حل الأزمة الأم, ولهذا حديث آخر.