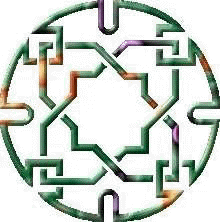
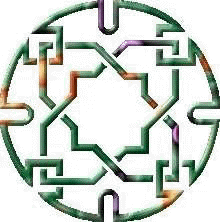



مجلة العربي الكويتية
1 أكتوبر 2007
د. عبد السلام المسدي وجهاد فاضل

في هذا الحوار، يُطلق مفكر وباحث ووزير سابق للتعليم في تونس، هو الدكتور عبدالسلام المسدّي صيحة تحذير مما آل إليه وضع اللغة العربية في السنوات الأخيرة، ومما يمكن أن يئول إليه أكثر في السنوات المقبلة.
فهو يقول إنه تحت ضغط اللغة الأجنبية وضغط العامية، تتأثر الفصحى ويتقلص نفوذها، وإذا استمر الأمر على ما هو عليه اليوم، وعمّا هو متوقع في المستقبل القريب، فإن العربية ستئول تدريجيًا إلى الضمور والأفول، وستتحول إلى لغة مرتهنة جدًا في طقوسات رسمية جدًا، أو تعبدّية جدًا، أو إبداعية في حدود ما.
ويحذّر د. عبدالسلام المسدّي من وضع دولي أصبح يساعد على الزهد بالفصحى، ويشجع على نمو حقول التداول بالعاميات. وليس هذا من باب المؤامرة لأنه لم يعد شيئًا مسكوتًا عنه، وإنما أصبح مرسومًا في سجلات الخطط الاستراتيجية الدولية. فهناك جهات دولية تعرض اليوم تمويلاً سخيًا لإنجاز مسلسلات عربية، شرط أن تكون بالعامية لا بالفصحى.
وفي التشريعات التربوية الجديدة في فرنسا، ألغيت العربية الفصحى كلغة أجنبية، وحلّت محلها مجموعة من العاميات العربية كعامية شمال إفريقيا، وعامية مصر، وعامية المشرق العربي. وفي فرنسا أيضًا تكوّنت أكاديمية للغة الأمازيغية، وبذلك تحقق فرنسا اليوم ما عجزت عن تحقيقه زمن «الظهير البربري» واستعمارها لشمال إفريقيا.
يتعرض د. عبدالسلام المسدّي في حواره مع «العربي» إلى وضع اللغة العربية في وسائل الإعلام العربية بالذات، حيث باتت العامية هي اللغة الأولى المتداولة فيها، كما يتعرض لمسلسل «افتح يا سمسم» الذي استُخدمت فيه اللغة العربية، ونجح نجاحًا منقطع النظير. ويرى أن المسألة برمتها بحاجة إلى قرار سياسي على أعلى المستويات شبيه بالقرار الذي اتخذته الصين كما اتخذته إسرائيل.
فما كان للمعجزة الصينية الحالية أن تقتحم القرن الحادي والعشرين على النحو المعروف، لولا ارتكازها على منظومة ثقافية لغوية واحدة. أما إسرائيل فإن لغتها العبرية الحالية كانت قد ماتت وحُفظت في الأدراج، ثم أُحييت من القبر وأصبحت لغة رسمية. فالقرار السياسي - إذن - ذو شأن، ولكن أين نحن العرب من قرار سياسي يعيد للغة العربية نفوذها، لا في وسائل الإعلام وحدها، بل في كل مجال من مجالات حياتنا العامة. المؤسف أننا أمة لا تنفك تعمل على تضييع هويتها اللغوية، ونحن نفعل هذا دون رؤية استراتيجية.
- في تصوّرنا أن الارتباط الوثيق بين المشروع التربوي والمشروع التنموي، أصبح خيار ضرورة في واقعنا العربي، ويمكن أن نؤكد، دون مجازفة، أن دخول مرحلة الوجود الكوني، أو ما يسمّونه العولمة، يحتّم علينا - فعلاً - البحث عن هذا الجسر بين التربية والتنمية. غير أننا في شكل عام، نحن العرب، في نطاق وعينا العام، كما في نطاق دساتيرنا النظامية، نهتم بالتربية، ونهتم أيضًا بعلاقتها بالدورة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، ونغمض الأعين عن المفتاح الأساسي في هذا الجسر الرابط بين اللغة والتنمية، وهو أداة التواصل التي هي اللغة.
يُخيّل إليّ أننا في جلّ الأحيان نهتم بالإشكالات الحقيقية في مجال المعرفة، ونواجه التحديات القاسية في منظومتنا المعرفية المتخلفة تجاه المنظومة المعرفية العالمية، ونبسّط بجرأة ما يُسمّى بالهوّة الرقمية في المستوى التكنولوجي، ولكننا لا نتجرّأ على مواجهة القضية الملازمة لكل هذا، وهي القضية اللغوية.
وعلى هذا الأساس، أرى أن مشاريعنا التربوية، ومشاريعنا التنموية ستظل مشلولة، منقوصة مالم نواجه القضية اللغوية، بصرف النظر عن الاختيارات، التي سننتهي إليها. ما أراه فظيعًا غير منسجم مع حركة العصر هو الصمت عن هذه القضية. إنني أعتبر ترك المسألة اللغوية حبلاً على الغارب، من الصمت الآثم في اختياراتنا، على مستوى الأنظمة، وأيضًا على مستوى النخبة الفكرية.
نحن والتعددية اللغوية
- نحن نعيش تعددية لغوية، منها تعددية لغوية معرفية، وهي مواكبة اللغة العربية للغات أجنبية مختلفة. لا يمكن لأي ثقافة أن تستغني عن التواصل مع اللغات والثقافات الأخرى. واللغات الأجنبية هي - بلاشك - الحليف الاستراتيجي للغة العربية.
هذا أمر معروف ومقر، ولكن المشكل الآخر هو وضع اللغة العربية داخل مجتمعاتنا، وفي اختياراتنا التربوية. لكننا بشكل رسمي كأننا متفقون على أن لغتنا المعرفية هي اللغة العربية الفصحى، ولكننا من الناحية الفعلية، ومنذ حقبة من الزمن تصادفت مع دولة الاستقلال بعد دولة زوال الاستعمار، أصبحنا نهمل شأن اللغة العربية الفصحى. تهجم، من ناحية، اللغة الأجنبية لتقلّص من إشعاعها، تضغط، من أسفل، العاميات التي ما فتئنا نكرّسها كأدوات تواصل في مجالات خُلقت لها اللغة العربية الفصحى.
إن ما يسمى بالازدواجية الأولى لقيام لغة فصيحة مع لغات أو عاميات مختلفة في الأقطار العربية، كان يمثل واقعًا تتجاوزه الأنظمة التربوية عندما كانت الدول العربية مستعمَرة.
كانت للغات العامية مجالاتها الطبيعية، وهي لغات مكتسبة بالأمومة تمثل الجانب العاطفي لدى العربي، تعطيه دفعًا للتعامل مع الحياة، تعينه على اقتحام مجاهيل الوجود، تساعده على إبداع الصورة التعبيرية الحية لانفعالاته، ثم تترك المجال للعربية الفصحى لكل ما هو معرفة وعلم وتفكير وجدل وارتقاء بالمفاهيم إلى مستوى الإبداع، أو إلى مستوى الروحانيات أحيانًا.
لكننا في الوضع الجديد، بدأنا غضّ الطرف ونسكت، فإذا بالعاميات، ولاسيما مع ضغط التواصل الإعلامي الغزير، مع انتشار الفضائيات التلفزيونية، تحلّ محل الفصحى، وأصبحت هذه العاميات هي اللغة التي يتداول بها الساسة أحاديثهم، والمثقفون خطاباتهم، وهي التي تسيطر على منابرنا الثقافية والفكرية أحيانًا.
في نهاية الأمر، ضغط باللغة الأجنبية وحضورها، وهو طبيعي وضروري، وضغط من أسفل بالعاميات، وجدت اللغة العربية الفصحى مضغوطة، وما انفكّ يتقلص مجالها. ولاشك أنها تدريجيًا ستئول إلى الضمور وإلى الأفول. وطبعًا ستئول بعد ذلك إلى الاضمحلال، وستصبح لغةً مرتهنة جدًا في طقوسات رسمية جدًا، أو تعبّدية جدًا، أو إبداعية في حدود ما.
هذا الوضع هو الذي ما ننفكّ نرسل الصيحة وراء الصيحة حتى يعيه أصحاب القرار، لأن المسألة سياسية فوق المسألة التربوية، لأنها خيار حضاري مصيري. ولا يخفى أن وضعًا دوليًا أصبح يساعد على الزهد باللغة العربية الفصحى، وأصبح يشجع على أن تنمو حقول التداول بالعاميات، لتحلّ العاميات محل العربية الفصحى. وهذا ليس من باب المؤامرة، لأنه لم يعد شيئًا مسكوتًا عنه، وإنما أصبح شيئًا مرسومًا في سجلات الخطط الاستراتيجية الدولية، سواء الأوربية منها أو الأمريكية.
وعلى سبيل المثال، نعلم جميعًا أن تجربة يومًا ما وقعت في إنتاج البرامج التلفزيونية مرّ الناس عليها مرورًا عابرًا، ولم ينتبهوا إلى أهميتها القصوى، وهي مسلسل «افتح يا سمسم». هذا برنامج أعدّ بخبرة عالية، وبتقنيات متميزة، وسُجّل وقتها في مختبر بنيويورك، وتضافر على إنجازه متخصصون متعددون من بينهم علماء نفس، وعلماء لغة عصريون. هذا البرنامج أعطى الانطباع المهم الأساسي، وهو أن اللغة العربية يمكن أن تكون لغة تداول، ويمكن أن تكون هي مفتاح هذا التواصل في مستوى المدرسة، ثم نسينا الموضوع.
اليوم هناك جهات تأتي إلى الوطن العربي معروفة، جاء منها فريق إلى الإسكندرية في مطلع سنة 2003، وتعرض تمويلاً في إنجاز مسلسلات جديدة مثل «افتح يا سمسم» بتمويلات سخية، شريطة أن تكون المسلسلات بالعاميات لا بالعربية الفصحى. وغني عن التذكير الإشارة إلى التشريعات التربوية الجديدة في بعض الدول الأوربية من بينها دولة فرنسا. فالجيل الثاني، أبناء المهاجرين منذ 1995، بدأوا يواجهون وضعًا تربويًا جديدًا. ألغيت اللغة العربية الفصحى كلغةٍ أجنبيةٍ تُختار في البكالوريا، وأحل محلها مجموعة من العاميات. قُسّمت العامية العربية في النظام التربوي الفرنسي الثانوي إلى ثلاث مجموعات: العامية المتصلة بشمال إفريقيا، ثم العامية المصرية، ثم العاميات المشرقية.
الآن أصبح التخطيط ساريًا لا على مستوى الخطاب الأيديولوجي أو الخطاب السياسي، أو النزعات فحسب، وإنما على مستوى الخطاب العلمي والأكاديمي والمعرفي أيضا، هناك أصوات تنادي بالتخلي عن اللغة العربية وإحلال العاميات محلها.
أضف إلى ذلك النزعة الحادة لجهات غربية لتغذية اللغات المنافسة للغة العربية، كاللغة الأمازيغية في شمال إفريقيا، وليس جزافًا أو صدفة أن بادرت فرنسا منذ زمان إلى تكوين «المجمع»، أي الأكاديمية، للغة البربرية في باريس.
وهناك الخطاب الماكر الملتفّ على الواقع الذي يريد أن يربط الإرهاب باللغة العربية ذاتها، بعد أن ربطه بالمعتقد الإسلامي، وبالتطرف والتشدد الديني. اليوم يربطونه باللغة العربية كما لو أنها لغة تحمل بذاتها، في ألفاظها وفي دلالتها جينات الإرهاب.
ليست محاولات بعض الجهات الأجنبية لإحلال العامية محل الفصحى، وحتى إيجاد صرف ونحو للأولى، محاولات حديثة. في نهاية القرن التاسع عشر، وفي حقب مختلفة من القرن العشرين، جرت سواء في مصر أو في لبنان محاولات شتى قام بها مستعربون، وحتى مثقفون عرب، هدفت إلى اتخاذ العامية بديلاً من الفصحى. لدى هؤلاء الدعاة حجج مختلفة، منها أن الازدواجية اللغوية، أي التحدث بلغة، والكتابة بلغة، مسألة تضر بالعقل وملكات الإبداع. ومع أن تلك المحاولات قد فشلت عمليًا، وبقيت الفصحى صامدة، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت تراجعًا مخيفًا للفصحى، وتقدمًا مذهلاً للعامية.
أنصار هذه الأخيرة يقولون إن الفصحى ابتعدت عن الحياة، وأن العامية باتت هي لغة الحياة اليومية الدافئة، وأن الذي يقرر موت لغة أو نشوء لغة ليس القرار السياسي أو الحكومي، بل حركة الحياة نفسها.
- أولاً من الضروري أن ندقق مسألة فنية:فالاهتمام بالعاميات من الناحية العلمية، والبحث في كل عامية عربية عن نظام الصوت والصرف والنحو، هذه مسألة علمية مشرّفة وتدخل في ما يسمّى بعلم اللهجات الديالكتيولوجية. وهذا شيء تأسس منذ زمان، وتحدث عنه ابن خلدون منذ زمان، ثم جاء العلم المعاصر، وبدأ به بعض المستشرقين، ونبّهوا العرب إلى أهميته، ونِعْم ما فعلوا. ومن موقع الاختصاص اللغوي، أشهد بأن اللغوي عندما يتعمّق في عاميته العربية، أو أي عامية من عاميات الأمة العربية، يكتشف فيها كنوزًا من إبداعية العقل البشري، والتركيبة الخلاقة. وهذا كله يدخل في باب العلم المشرف وهو علم اللهجات.
علم اللهجات قام أساسًا، وهو معزز للغة العربية الفصحى، وهو متكئ على لغة أجنبية سليمة، ويستعمل مقولات علمية ليس لها منافذ للصراع الداخلي.
اليوم القضية تختلف. اليوم القضية تبسط على مستوى الخيارات، البدائل: إما العاميات أو الفصحى، وعلى هذا الأساس ما أشرتم إليه، قد يدخلنا في جدل ما يسمّيه علماء المنطق بالدور والتسلسل. هل اللغة هي نتيجة الواقع اللغوي، أم الواقع اللغوي هو نتيجة اختيارات؟
المسألة محسومة. اليوم لدينا منابر. المنابر الإعلامية تمثل مدرسة. انظر - على سبيل المثال - إلى المنابر الإعلامية الأجنبية، وآخذ نموذجًا معينًا لأني أخذته أكثر من غيره، هو نموذج المنابر الإعلامية الفرنسية، على مستوى الفضائيات أو على مستوى الإذاعات. البرامج التلفزيونية اليوم مهما كان محتواها، حتى التي تتحدث عن الرياضة أو عن الرقص، هي في اللحظة نفسها مدرسة لغوية لمَن يستمع إليها، لأنها تُصاغ صياغة محكمة سلسة طبيعية عادية، ولكنها سليمة. هذايمثل جزءًا من البيئة.
نحن في واقعنا العربي، البيئة، المناخ المحيط بالطفل، يسيطر عليه التلوث اللغوي. يدخل إلى المدرسة، فيريد أن يكتسب اللغة العربية الفصحى بتعثر كبير، ولكنه إذا خرج من المدرسة ينتبه إلى البيئة، إلى المناخ اللغوي، يجده معولاً يحطّم ما اكتسبه في الصف، في القسم، في المدرسة، المنابر الإعلامية، باستثناءات قليلة، نشرات الأخبار، أو بعض الخطب الرسمية، أو الخطب الدينية، وحتى هذه دخلتها العامية، بل هناك فضائيات تقدم الآن نشرات الأخبار بالعامية. هناك فضائيات إذا راسلت أحد الذين يقومون بعملية الريبورتاج، فالريبورتاج يجري باللغة العامية.
هذه واحدة. الفيض الإعلامي والجاذبية الإعلامية على الفضائيات بانتشار القطاع الخاص في مجال البث الغزير، جعل المنزع نحو استقطاب المنشطين الذين يُحيون البرامج. هؤلاء أصبحوا يتعمّدون أساليب الإغراء. أساليب الإغراء ليست في الشكل فقط، وإنما أساليب الإغراء اللغوية والإغراء اللغوي للشباب، لا يتم إلا عن طريق لغة الشارع، لغة الشباب. فهذا أيضًا عامل ثان يُزهد في اللغة العربية الفصحى. ونحن الآن بصدد مشاهدة ظواهر على غاية من الغرابة. يُتناول في الأجهزة الإعلامية برامج جادة، عميقة. الألفاظ فيها جاهزة لأنها من المفاهيم القوية. فإذا به يُطلب إلى الذي يُستضاف، بأن يتكلم باللغة العامية، حتى يفهم الناس. فإذا به يكسر الأوضاع، ويلوي أعناق اللغة ليتحاشى اللفظ الفصيح، ويبحث عن لفظ سوقي عادي أو شعبي.
وضع لغوي شاذ
نحن في وضع لغوي شاذ جدًا. ونحن أمة لا تنفك تعمل على تضييع هويتها اللغوية. والمؤسف والمحزن أننا نفعل هذا دون رؤية استراتيجية. يُخطط لنا، ثم نقول إن الواقع يحملنا، أو يجرفنا. بينما نحن الذين حققنا هذا الواقع. ونحن الذين بوسعنا أن نغيّر الواقع. ويجب أن نتمثل التاريخ القريب لا البعيد.
لا يمكن لأمة أن تصنع سيادتها دون منظومة لغوية، دون رؤية لغوية. يكفي لمن أراد أن يتأكد من هذا، أن يعلم الأمثلة التالية: إن علم اللغة الحديث، ما يسمى باللسانيات، ازدهر في مطلع القرن العشرين في الولايات المتحدة لأسباب سياسية عسكرية. عندما كان الشعب الأمريكي أخلاطًا، عندما كان الشعب الأمريكي يتحاور بلغات شتى مختلفة، أريد سياسيًا أن يوحَّد لغويًا، فانكبّ اللغويون لدراسة القضية اللغوية، وسهّلوا مهمة التوحيد اللغوي، فتم التوحيد اللغوي. هذه واحدة.
الثانية لمن يقرأ التاريخ، كيف تكوّن الاتحاد السوفييتي. تكون انطلاقًا من تأسيس لغة رسمية روسية هي القاسم المشترك بين كل الأقليات الاثنية والثقافية.
والمثال الأعظم هو اللغة الصينية. كان الشعب الصيني، أو الجمهوريات الصينية أشتاتًا لا حدّ لها. وهو مازال. ولكن القرار السياسي جعل اللغة الصينية لغة رسمية وحّدت الأمة الصينية.
واليوم نحن نشهد معجزة، بداية معجزة القرن الواحد والعشرين، وهي المعجزة الصينية، وما كان لهذه المعجزة، التي تقتحم القرن الواحد والعشرين أن تقوم، على ما يقول الخبراء، وأن تصبح عملاقًا اقتصاديًا وسياسيًا لولا أنها مرتكزة على منظومة ثقافية لغوية بالذات.
ثم آخر الأمثلة هو فرنسا. فرنسا فيها اختلافات اثنية، وفيها مجموعات لغوية. فالقرار الفرنسي الدائم المتكرر حتى الآن هو كبح جماح لغات الأقليات باسم قانون التجانس القومي. وهو قانون يُعبد عبادة في فرنسا حتى لا تتفتت الأمة.
نحن إذن أمام أوضاع تاريخية صادمة فاقعة للعينين، ولكن أصحاب القرار عندما يتغافلون، يغفلون، يغيّبون الوعي، يستجيبون لإملاءات؟! لست أدري، كلها افتراضات واردة، ولذلك أردنا أن نكرر الصيحة، التي ما ننفك نرسلها على مستوى بث الوعي.
ولا ننسى أيضًا اللغة العبرية، التي تمثل مثالاً استثنائيًا في تاريخ الأمم، لغة ماتت وحُفظت في الأدراج، ثم أُحييت وهي في القبر، وأصبحت لغة رسمية. القرار السياسي إذن هو ذو شأن في هذه المسألة.
العامية وضغط الواقع
- الحقيقة أننا لسنا في مقام الحكم على المقاصد، وقضية براءة النية، أو عدم سلامتها، لا تغيّر شيئًا من الواقع. نحن هنا - كما يقال في المجال اللغوي - اختباريون براغماتيون. ما هو الواقع؟
المسألة التي تتفضلون بها مسألة مهمة جدًا. يجب أن نعرف أنه في كل ثقافات الدنيا، اللغة التي تُكتسب بالأمومة، وتصبح هي لغة التداول ليست هي بالضبط والتحديد، اللغة التي تُكتب بها الكتب، وتؤلف. هناك دائمًا فارق، يبقى أن هذا الفارق له مساحة من حيث الكم، وله قياس من حيث النوع.
الواقع عندنا في واقعنا العربي هو التالي. نحن نعلم أننا أمة مازالت تعاني نسبة حوالي 60 في المائة من الأمية. إذا كانت لنا رؤية استراتيجية، ونريد أن نتعامل مع المستقبل فماذا سيحدث؟ نرفع الأمية، وهو ضرورة. إذا رفعنا الأمية، فإن الجيل الذي سينشأ هو جيل يكتسب بالأمومة اللغة العامية، التي تكون عندئذ قد ارتقت إلى اللغة العربية الفصحى، وتكون في الحقيقة هي اللغة، التي يتداول بها المثقفون اليوم شئونهم عندما يلتقون، أو يشربون القهوة، أو يتلاقون في كواليس المؤتمرات. يتحدثون بلغة هي في تركيبتها النحوية لغة عامية، ولكنها في جداولها، في مفاهيمها، في بناها العامة قريبة للفصحى. هي لغة الفصحى، سقط منها حركات النحو في أواخرها، وبعض تصريفات الأفعال وعلاقة المفرد والجمع في تركيب الجملة.
هذا هو الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي أن أمة لترتفع منها الأمية، فترتقي لغتها التي هي عامية، وتُكتسب بالأمومة. ونتخيل الآن، انظر إلى بيت الأب والأم والأخوة فيه مثقفون، وينشأ طفل جديد. البيت الذي يكون فيه الأبوان مثقفين، ينشأ الأبناء بلغة الأمومة المكتسبة أولاً في مستوى أرقى من المستويات العادية في البيئات الأخرى.
من ناحية أخرى، عندما نعطي للغة العربية دفعًا اعتباريًا، وعندما تصبح هي رمزًا للسيادة، وعندما يتداولها السياسيون والمثقفون والفنانون ولاعبو الرياضة. عندما يقع كل هذا، ستكون اللغة العربية الفصحى هي تلك اللغة التي تُكتب بها نشرات الأخبار، لا تلك التي كُتب بها الشعر الجاهلي. أو، على وجه التقريب، هي تلك اللغة التي أنجز بها مسلسل «افتح يا سمسم» على سبيل المثال. مَن لا يفهمها؟ أو هي اللغة التي يتحدث بها المثقفون، أو تلك التي يتحدث بها خطيب الجمعة، وتُنقل على التلفزيون، مفهومة، حتى الأمّي يفهمها.
إذن، إذا كانت هناك إرادة سياسية، تتبعها إرادة ثقافية، وتتبعها المنظومة التربوية، فإننا سنقترب شيئًا فشيئًا من وضع الأمم الأخرى. وهي أننا نعيش لغة قائمة الذات، عاميتها قريبة منها، وفصيحها قريب من عاميتها: تتقلص الهوّة التي هي قائمة بين المستويين، وتُفضّ القضية اللغوية مع اعتبار أننا إذ ذاك نتفرغ، فضلاً عن اكتساب اللغة العربية الفصحى، إلى اكتساب أكبر عدد ممكن من اللغات الأجنبية حتى نواجه العالم.