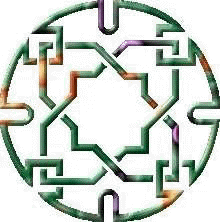
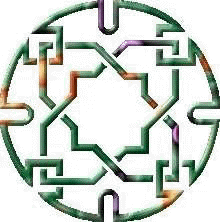



مجلة العربي الكويتية
1 مارس 2008
جابر عصفور

ربما كان من الأصوب في هذا المقام، أن نتحدث عن أزمات اللغة العربية التي تكاثرت في هذا الزمان، وامتدت إلى كل المجالات.
و«الأزمة» في اللغة هي الشدة والضيق (من أُزَمَّ العام إذا اشتد قحطه، واشتد كربه)، وكثيرة هي أوجه الخطر التي تتهدد اللغة العربية من كل اتجاه. ولذلك كثرت الشكوى من تدهورها على ألسنة الناطقين بها، سواء في المحافل العامة أو المنتديات النوعية. لا فرق في ذلك بين التجمعات السياسية أو الثقافية أو الملتقيات الإبداعية. ولم تعد الخطابة السياسية نموذجا للسلامة اللغوية والفصاحة الأسلوبية، كما كان يحدث في جيل الليبراليين الكبار، سعد زغلول والنحاس والعقاد وطه حسين.. وغيرهم، وإنما غدت نموذجا للركاكة وخلل الأداء اللغوي، خصوصا حين يترك الخطيب النص الذي لا يحسن قراءته إلى اللهجة العامية وما يشوبها من رواسب لا علاقة لها باللغة العربية الفصحى في نقائها وصفائها، ويوازي ذلك تدهور الأداء اللغوي حتى في الحياة الجامعية التي غلبت العامية على محاضراتها، وفشت الأخطاء النحوية والإملائية والأسلوبية في الرسائل العلمية والكتب الجامعية، وشاع اللحن في خطاب الأساتذة والأستاذات، حتى أولئك الذين ينتسبون إلى أقسام اللغة العربية ومعاهدها وكلياتها، وأضف إلى ذلك الكليات والمعاهد الأزهرية. كما لو كان وقع الحال يذكّرنا بالمثل الشعبي الذي يتحدث عن «باب النجار المخلّع».
ومن الطبيعي أن يقترن بذلك كله خطاب الذين يتحدثون ليل نهار عن احترام التراث، وضرورة العودة إلى الماضي، بوصفه الوضع الأمثل، ومبدأ الزمن الذهبي الذي يتدهور، كلما مضينا إلى الأمام، وكلما ابتعدنا عن التأسي به في كل تطلع إلى المستقبل، كما لو كنا أمة عيناها في قفاها، وتغفو عن حاضرها ومستقبلها كما تغفو عن ماضيها الذي تتشدق بالعودة إليه وإلى ميراثه الديني الذين تتأوله فتشوهه. أقول من الطبيعي أن يقترن ضعف الأداء اللغوي بدعاة التراث على هذا النحو، الأمر الذي يدفعهم إلى التلويح بتهم التكفير التي يطلقونها كالرصاص على خصومهم. وذلك حال يكشف عن تناقض موقف هؤلاء التراثيين المتعصبين الذين يتعصبون لتراث لا يحسنون لغته،ولا يريدون من يسرها إلا عسرها.
ولا يختلف عن هؤلاء المتعصبين نقائضهم الذين يمثلون الوجه الآخر من العملة، أقصد أولئك الذين لايزالون ينطوون على عقدة «الخواجا». وهي عقدة نقص لايزال يعانيها أبناء الأقطار التي تحررت من الاستعمار العسكري، ولكنها لم تتحرر من عقد الدونية التي خلفها هذا الاستعمار دون برء، ولذلك لاتزال قاعدة ابن خلدون عن ولع المغلوب بتقليد الغالب سارية، تتمثل في جعل النماذج الثقافية للآخر المتقدم الغالب هي النماذج العليا المحتذاة شعوريًا ولا شعوريًا، بما في ذلك لغته التي تداخلت حتى في عاميات هذه الأقطار التي لاتزال تعاني من سلبيات الفرانكوفونية والأنجلوفونية، خصوصا الأولى التي لاتزال تسعى إلى إكمال عمليات «التعريب» التي هي - في النهاية - البديل الملازم لظاهرة التعريب اللغوي السائدة والتي لاتزال مستمرة، خصوصًا في دول شمال إفريقيا. ومن أشمل تعريفات «التعريب» - في هذا الاتجاه - ما ورد في الوثيقة الصادرة عن وزارة التربية الوطنية بالمغرب الأقصى، مقدمة لمؤتمر التعريب الأول المنعقد في الرباط سنة 1961، حيث نقرأ: «التعريب بالمغرب هو إحلال اللغة العربية في التعليم محل اللغات الأجنبية، وتوسيع اللغة العربية بإدخال مصطلحات جديدة عليها، وإلزام الإدارة بعدم استعمال لغة دون اللغة العربية، والعمل على أن تكون لغة التخاطب اللغة العربية وحدها، والدعاية لها، ومقاومة كل الذين يناهضون لغتهم للتفاهم في ما بينهم بلغة أجنبية، وبالجملة، فإن التعريب هو جعل اللغة العربية أداة صالحة للتعبير عن كل ما يقع تحت الحس، وعن العواطف والأفكار والمعاني التي تختلج في ضمير الإنسان الذي يعيش في عصر الذرة والصواريخ».
بقايا الفرانكوفونية
والواقع أنه على الرغم من تبني المؤسسات الرسمية في أقطار المغرب هذا المفهوم للتعريب، وعملها على إحلاله وإشاعته، فإن المجموعات الشعبية وأصحاب الحرف التقليدية، في الأسواق الشعبية، لاتزال محافظة على رواسب «الفرانكفونية» التي لاتزال سائدة في خطاب الشارع والتجمعات الشعبية. وهو الأمر نفسه الذي لايزال يدفع عددًا دالا من كتاب هذ الأقطار إلى الكتابة بالفرنسية إلى هذا اليوم، كما يفعل الجيل الذي تلقّى تعليمه بواسطة الأدوات الأيديولوجية للاستعمار الفرنسي سابقًا، ولولا ذلك لكنا نقرأ باللغة العربية عشرات من كتاب الدول المغاربية، ومنهم على سبيل المثال محمد ديب والطاهر بن جلون ومولود معمري ومالك حداد وإدريس شرايبي وآسيا جبار ورشيد بوجدرة وكاتب ياسين وغيرهم من الكتّاب الذين تختلف أجيالهم واتجاهاتهم الفنية.
ومهما تحدثنا عن أوجه الاختلاف بين الدول العربية المتحررة من الاستعمار الفرنسي وشقيقاتها المتحررة من الاستعمار البريطاني، فإن الرواسب المنعكسة على أنواع الأداء اللغوي لاتزال واحدة، مؤتلفة في الجوهر، مختلفة في المظهر فحسب، حتى دول الخليج التي لاتزال تحمل لهجاتها مفردات فارسية وأردية وهندية، ولاتزال تشيع بعض لغات أجنبية بين مجموعات العمل المنتشرة فيها إلى الحد الذي ينطبق معه معنى بيت المتنبي:
كأن الفتى العربي فيها غريب الوجه واليد واللسان
وعلى من لا يصدق ذلك أن يمضي في بعض أسواق دبي أو غيرها من أقطار الخليج التي بدأ الأطفال فيها يحسنون لغة العمالة المحيطة بهم، خصوصًا في المنازل، أكثر مما يحسنون لغتهم الأم. وهو أمر لابد أن يدق جرس الإنذار في هذه الأقطار التي ينتج فيها عن التنوع العرقي غير المنضبط تنوع لغوي يوازيه في القوة والخطر على اللغة العربية وأبنائها على السواء. وأنا أفهم وجود تنوع عرقي في عمالة هذا القطر الخليجي أو ذاك، ولكن تحول هذا التنوع إلى تنوع سلبي له مخاطره الممكنة في مدى الثقافة واللغة الحاملة لها والمبقية عليه، فهذا هو الخطر بعينه الذي ينبغي أن يحتل موضع الاهتمام، ويتطلب المعالجة في مجلس التعاون الخليجي، ما ظلت دوله تسعى إلى الحفاظ على نقاء وسلامة اللغة العربية التي تكونت وتأسست في فضاءاتها التاريخية التي أصبحت مدى لإمكان انحدارها.
أزمة التعليم اللغوي
ويزداد هذا الإمكان انحدارًا، حين نضع في اعتبارنا غير ذلك من مجالات الاستخدامات اللغوية المختلفة، أو حقول عملها، وعندئذ، يمكن أن نضيف إلى ما سبق ما يلي:
أولاً: التعليم اللغوي الذي لا يشك أحد في عدم ارتفاعه إلى آفاق التحديات المعاصرة الواقعة على اللغة العربية، فأنظمة تعليمنا لاتزال على ما كانت عليه من تقاليد بالية في مجالات كثيرة، على رأسها مجالات التعليم اللغوي التي لم تتطور إلى اليوم بما يتناسب واحتياجات العصر، بل بما يتجاوب والدوافع الملحة لإصلاح التعليم اللغوي بوجه عام.
والنتيجة هي تقليص تعليم اللغة العربية، مقابل التوسع في تعليم الإنجليزية في بعض دول الخليج. والواقع أنه لا فارق كبيرا بين تعليم اللغة القومية واللغات الأجنبية في هذ المجال، فالخلل في آليات ومناهج تعليم اللغات عام وشائع، يلقي بثقله على تعليم اللغة القومية التي توضع مشكلات تعليمها في ذيل قوائم الأولويات لعدم أخذها مأخذ الجد في التعليم. وإلى اليوم، لاتزال في انتظار مخططات واستراتيجيات أكثر ثورية، وأكثر عصرية، في التدريب على النطق، وحل مشكلات الإمارة، وتحسين الخط، وتبسيط النحو، وتضييق المسافة بين المنطوق والمكتوب، أو العامية والفصحى، وغير ذلك من عمليات التحديث المبتكر التي تنقلنا إلى أفق جديد من التعليم، وأفق أجدّ من البحوث التربوية التقنية في آليات التعليم اللغوي وأساليبه. وأتصور أن هذا البعد الأخير للمشكلة هو بعدها الأول، ذلك لأن التعليم، خصوصًا في مراحله الأولى، هو حجر الزاوية في التثقيف اللغوي للناشئة الذين لابد أن ينشأوا نشأة لغوية سليمة في المدرسة على الأقل، خصوصًا أن الكثير مما حولهم يربك هذه النشأة: ازدواجًا في اللغة ما بين العامية المتكثرة والفصحى المتقلصة، لغة الرموز السياسية والاجتماعية والفنية والدينية... إلخ. ولن ينصلح حال تعليم اللغة القومية في المدرسة إلا إذا تشرّب التلامذة حب اللغة من أساتذتهم الذين يجب أن يُعدوا إعداد تربويًا وعلميًا مغايرًا، وأن يواصلوا البحث والتدريب دون انقطاع، أو على الأقل يلحقوا بدورات تدريبية متواصلة لتطوير أدائهم، وأن يكونوا قدوة لطلابهم في تجنب الخطأ في الوقت نفسه، وإيثار السلاسة الفصيحة في التعبير.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك أهمية تشجيع الطلاب على التميز في معرفة لغتهم وامتلاك ناصيتها التعبيرية بمسابقات جادة لها احترامها (في الولايات المتحدة: مسابقات - على مستوى الولايات - في هجاء الكلمات، والقراءة)، وفي الوقت نفسه، تشجيع الباحثين على مواجهة مشكلات تعليم اللغة وتدريسها في المراحل المختلفة، وخلال فترات زمنية محددة، بما في ذلك تعليم اللغة لغير الناطقين بها بأيسر السبل وأنجعها، ولا ينفصل عن ذلك تطوير اللغة القومية ضمن منظومة أشمل لتطوير تعليم اللغات كلها، ذلك لأن ضعف عملية التعليم وسلبية نواتجها أمر عام، تتبادل أطرافه التأثر والتأثير في مدارسنا العربية التي لايزال نظامها التعليمي في خطر إلى اليوم.
ثانيًا: الإعلام الذي لايزال عاملا من عوامل تهديد اللغة الفصحى وذلك بتشجيعه العاميات المحلية واستخدامها الجاذب في المسلسلات والأغاني، وغيرها من أنواع التطرف في الاستخدام الدرامي التي تتحول إلى نماذج للتقليد، وخصوصا بين الناشئة، ويتصل بذلك عدم التقديم الناجح لبرامج تعمل على جذب الأطفال إلى لغتهم الجميلة، وتبصير الكبار بكنوز هذه اللغة وإتاحتها لهم على أيسر وجه وأجذبه. ومع الأسف، فإن أغلب أجهزة الإعلام القائمة تعمل في اتجاه مضاد، وتشيع نوعًا من الاستهانة باللغة القومية في صحافتها أو تلفزيوناتها، في المسلسلات الضاحكة أو الأفلام (ولنتذكر نموذج الأستاذ حمام - نجيب الريحاني - في فيلم «غزل البنات» الذي تكرر في نماذج لاحقة) وقارن بين الأفلام العربية في هذا المجال وما يقابلها من نماذج غربية، كانت تهدف إلى تأكيد أهمية اللغة ودورها في الصعود الاجتماعي كما حدث مع بطلة «بيجماليون» في مسرحية الكاتب الإنجليزي برنارد شو (التي تحولت إلى فيلم شهير بعنوان «سيدتي الجميلة»).
والواقع أن التلفزيون يؤدي دورًا سلبيًا في هذا الاتجاه، وبدل أن يكون عامل تأكيد لحضور اللغة العربية الفصحى، فإنه يتحول إلى قوة هدم غير مباشر بتشجيع العامية في المسلسلات والحوارات التي تتحول إلى نماذج لغوية يقتديها بوعي وغير وعي المتلقون من مختلف الأعمار، خصوصا حين يرون «نجوم» مجتمعهم في أغلب المجالات يتحدثون إما بفصحى ركيكة أو بعامية تقتحم حتى الفصحى وتعديها بالركاكة.
ثالثًا: ويتصل بذلك الخطر الأخير الذي تواجهه اللغة العربية على نحو غير مباشر، ويتصل بالعولمة وما اقترن بها من تغيير جذري، غير مسبوق، في وسائل الاتصالات، ومنها شبكات الإنترنت التي أدّت إلى شيوع اللغة الإنجليزية، وجعلها لغة مهيمنة، بسبب تركز أسباب القوة في البلاد الناطقة بها، والنتيجة غلبة اللغة الإنجليزية على اللغات المستخدمة في وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بالقياس إلى اللغة العربية، التي يتقلص نفوذها ومدى انتشارها الدولي على السواء. ويعيدنا هذا الخطر الجديد إلى غيره من الأخطار التي أصبحت تتمثل في ما تفرضه العولمة الاقتصادية من غزو الكلمات الأجنبية لأسماء الشركات العالمية والمحلية التابعة لهذه الشركات، أو المرتبطة بها على نحو أو غيره.
مقاومة غزو الكلمات الأجنبية
ونتيجة لذلك كله، لا يكف الغيورون على لغتهم القومية عن الدعوة إلى ضرورة مواجهة طوفان الكلمات الأجنبية التي غزت اللافتات والإعلانات في المجلات والصحف، خصوصًا بعد أن أصبحت الصحف العربية في مصر وغيرها، لا تتردد في نشر إعلانات كاملة باللغة الإنجليزية، وبعد أن أصبحت الكلمات الأجنبية على كل لسان، وأصبحت أسماء للجديد المتزايد من الشركات والمشروعات والمدن الجديدة والمحلات التي ينتسب أصحابها أو القائمون عليها إلى الثقافة العربية، الأمر الذي دعا وزير التجارة المصري السابق، أحمد جويلي، وهو أستاذ جامعي أصلا، إلى إصدار قرار بمراجعة الشركات والمحال التي تحمل أسماء أجنبية، وإنذارها بتعديل أسمائها طبقًا للقانون رقم 155 لسنة 1958، وهو القانون الذي ينص على استخدام اللغة العربية في المعاملات والإعلانات التجارية. وكان دافع وزير التجارة الأسبق (إلى إعمال القانون الذي طواه النسيان) ينطلق من الوعي بضرورة الحفاظ على لغتنا التي هي عنوان هويتنا القومية، كما يقوم على أساس أنه لا يصح في معنى الاستقلال الوطني أو القومي تجاهل أو تشويه أو استبدال هذه اللغة بأي حال من الأحوال.
وتلك خطوة لابأس بها بالتأكيد. ويستحق موقف وزير التجارة الأسبق التنويه والتقدير. لكني لا أعرف مدى إمكان تنفيذ قراره عمليا، الآن، خصوصًا بعد أن اتسع الخرق على الراقع كما يقول المثل القديم، وتجاوز الأمر مصر إلى غيرها من الأقطار العربية، بل قامت أجهزة الدولة نفسها، وفي أعلى مستوياتها، بالموافقة على إنشاء شركات ومشروعات جديدة ذات أسماء أجنبية، وأصبحت الإعلانات باللغة الإنجليزية بوجه خاص لازمة من لوازم التصاعد المتزايد في عدد الشركات المرتبطة بمشروعات العولمة الاقتصادية بأكثر من سبب، كما أصبح إتقان اللغة الأجنبية شرطًا أساسيًا من شروط القبول في الوظائف المتميزة بالشركات والمشروعات الاستثمارية المتدافعة مع موجة الانتقال إلى الاقتصاد الحر، ومن ثم مصدرًا أعلى للدخل وعلامة على التميز الوظيفي. ولم يكن من المصادفة - والأمر كذلك - أن تقدم بعض كليات التجارة وغيرها، في الجامعات المصرية، مثلا، على فتح أقسام للتدريس باللغة الإنجليزية من الألف إلى الياء، أو تسعى بعض الدول إلى تغليب اللغة الأجنبية السائدة على غيرها من اللغات، مع الاستبعاد التدريجي للغة العربية في البرامج العلمية المختلفة.
أضف إلى ذلك ارتباط الرطانة الأجنبية التي تتزايد معدلات شيوعها في تداولات الخطاب اليومية بالتميز الاجتماعي الثقافي الذي لا يخلو من المباهاة بمعرفة اللغات الأجنبية، وترصيع الكلام بمفرداتها أو اصطلاحاتها، حتى يبين الذين لا يتقنون هذه اللغات أو يعرفون منها القشور دون اللباب، ويمضي هذا الوضع في قران دال مع تدهور معرفة اللغة العربية على مستويات عديدة، وارتفاع درجات فقر الأداء اللغوي حتى بين الذين يطالبون بحماية هذه اللغة.
عاشق الضاد
ولا أنسى في هذا المجال أن بعض الغيورين على لغتنا القومية حاولوا الاستعانة بمجلس الشعب في مصر، وحثه على إصدار تشريع أو تشريعات تحمي اللغة القومية وتصونها. وتقدم النائب فهمي عمر - وكان مذيعًا مقتدرًا في أدائه اللغوي بالإذاعة المصرية - بمذكرة حول الموضوع إلى لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب، في دورة من الدورات التي كان لايزال فيها عضوا بالمجلس، واستجابت اللجنة إلى المذكرة، ودعت إلى جلسات استماع من المختصين. كان من أبرز المتحدثين فيها رئيس مجمع اللغة العربية السابق في القاهرة، أستاذنا شوقي ضيف رحمه الله، ومعه الأمين العام للمجمع في ذلك الوقت، ومجموعة من خبراء الإعلام والثقافة والتعليم العام والعالي، وانتدبتني وزارة الثقافة لتمثيلها. وكان أبرز الإعلاميين الحاضرين طاهر أبوزيد المذيع المخضرم - عاشق الضاد - الذي سعى إلى تأسيس جمعية محبي اللغة العربية في القاهرة. (وقد أخبرني الدكتور ناصر الدين الأسد أن هناك جمعية بالاسم نفسه تأسست في المغرب الأقصى). وبعد انتهاء جلسات الاستماع، قامت اللجنة بإعداد تقرير عن أزمة اللغة العربية ضم آراء المختصين ونواب المجلس من أعضاء اللجنة على السواء. وذهب التقرير إلى أمانة المجلس التي قررت وضعه في جدول الأعمال لمناقشته، تمهيدًا لإصدار التشريعات والتوصيات اللازمة، ودعيت أكثر من مرة إلى حضور جلسات المجلس نائبًا عن وزير الثقافة، وحضرت بالفعل أكثر من جلسة، لكن كان المجلس في كل مرة يقرر تأجيل مناقشة التقرير لانشغاله بما هو أهم، إلى أن انتهى الحال إلى نسيان التقرير والموضوع تمامًا.
وقد جاءت تجربة ثانية بعد التجربة الأولى، شهدتها في قاعة من قاعات مجلس الشعب لمناقشة تقرير مقدم من مجمع اللغة العربية بالقاهرة إلى مجلس الشعب. وقد حضر رئيس المجلس نفسه اللقاء وجلس على جانبيه وزير الثقافة ورئيس المجمع الحالي د.محمود محفوظ، مدّ الله في عمره، ونائبه د.كمال بشر، وتغيّب وزير التربية والتعليم، وهو في ذاته أمر له دلالته، إلى جانب دلالة تغيب وزير التعليم العالي. وتحدثت إلى جانب المتحدثين، بعد أن أنابني وزير الثقافة للتحدث باسم الوزارة، وأفضت - مع المتحدثين - في مظاهر الأزمة التي تعانيها اللغة العربية. وأضاف أمين المجمع عرضا للتوصيات التي يتقدم بها المجمع ليحيلها مجلس الشعب إلى مشروع قانون، وبالطبع، عبّر رئيس مجلس الشعب الذي ترأس الجلسة عن مشاركته المتحدثين في مظاهر الأزمة وضرورة التصدي لها. وأخيرًا، انتهت الجلسة وعاد كل متحدث إلى ما كان فيه.
ومرّت الأيام والشهور،وقد حدثت الجلسة قبل شهور معدودة من هذا العام، ولم نسمع عن إجراء اتخذه مجلس الشعب الذي بدا كما لو كان قد نسي، ورئيسه، الموضوع تماما، كأنه لم يكن، وكما لو كانت لجنة الثقافة والإعلام لم تطالب، من قبل، بإدراج الأزمة في جدول أعمال المجلس الذي لايزال منشغلاً بقضاياه المعتادة.
اللغة عنوان الهوية
وما خرجت به من هاتين التجربتين أمران: أولهما عدم الجدية في مناقشة تدهور أحوال اللغة القومية وأوضاعها، ذلك على الرغم من التأكيدات المتكررة والبيانات الحماسية عن ضرورة الحفاظ على الهوية وأهمية صيانتها بما يكفل لها القوة والنماء، وما أكثر ما نسمع في هذا المجال من أقوال خطابية عن مخاطر «الغزو الثقافي» وشرور «العولمة» القادمة، لكن ما أقل ما نرى من أفعال حقيقية، على الأقل في ما يتصل باللغة التي هي عنوان الهوية وعلامتها. وقد بدأت انطباعاتي عن عدم الجدية من جلسات الاستماع نفسها، حيث غلبت العبارات الإنشائية المصاحبة للشعارات الرنانة والصيغ الحماسية، وغابت لغة التفكير العلمي التي تعتمد على التحليل العميق للظواهر في تشابكها، أو المعرفة الفعلية للأوضاع في دقائقها، وتجسيد ذلك في إحصائيات كاشفة وأرقام دالة وحلول عملية. وتأكدت هذه الانطباعات بالغياب المتكرر لأغلب أعضاء اللجنة عن جلسات الاستماع، وبالتعليقات التي كانت تصدر عن بعض الحاضرين الذين ما كانوا يترددون في إظهار استخفافهم بمناقشة الموضوع أصلا.
أما الأمر الثاني فيرتبط بالأداء اللغوي نفسه لأعضاء مجلس الشعب، حيث العامية هي الأصل في التعبير، والفصحى هي اللغة الأجنبية التي تترجم إليها العامية مراعاة لمقتضيات اللياقة أو الحال أحيانًا. وأعترف أنني سرعان ما انشغلت عن متابعة مناقشة مشروعات القوانين في الجلسات التي حضرتها - في مجلس الشعب - بمتابعة الخطاب اللغوي للمتحدثين من النواب على اختلاف فئاتهم. وأخذت أقارن في ذهني بين الصورة التي عرفناها عن البرلمانات القديمة التي كان يصول ويجول فيها أمثال سعد زغلول والنحاس ومكرم عبيد والعقاد من ممثلي الوفد، وأمثال عبدالخالق ثروت ومحمد حسين هيكل من الأحرار الدستوريين وغيرهم من فرسان الفصاحة، والصورة التي كنت أراها أمامي من غياب الفصاحة، وشيوع الركاكة اللغوية، وخلط الفصحى بالعامية، والأخطاء البشعة في النطق والنحو والتراكيب. وبالطبع، لم يخل الأمر من استثاءات، لكن ندرتها لم تمح من ذهني الصورة الغالبة التي جعلتني أضع في اعتباري البعد السياسي الذي يسهم في تدهور الأداء اللغوي العام في المجتمع.