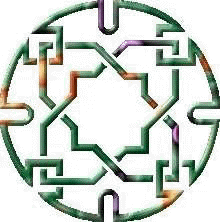
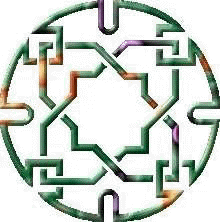



مجلة العربي الكويتية
1 يونيو2023
بسام بركة
جان باتيست برونيه، الفيلسوف الفرنسي المستعرب، وأستاذ الفلسفة العربية بجامعة باريس الأولى، الذي بدأ بتعلم اللغة العربية (في التسعينيات)، ثم أصبح أستاذًا جامعيًا وبروفيسورًا (في العام 2011) للفلسفة العربية، أكد في حوار خاص لـ «العربي» أن تأثير الفلسفة العربية في الفكر الغربي كبير، لدرجة أننا لا نستطيع فهم الفكر «الغربي» فهمًا صحيحًا ودقيقًا من دون الفكر العربي، وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
● جان باتيست برونيه، أنت فيلسوف مستعرب، كيف يُمكن لمواطنٍ فرنسي أن يصبح من كبار المُتخصّصين في الفلسفة العربية الإسلامية؟ هل بالإمكان أن تختصر لنا مراحل حياتك، الخاصة والأكاديمية، والظروف التي جعلتك تتعلم لغة الضاد وتدرس الفلسفة العربية؟
ــ ليس من السهل الإجابة عن هذه الأسئلة، فلا أحد يعرف تمامًا ما يسوس حياته ويوجّهها. هناك عوامل ترتبط بالحياة الخاصة، وباللقاءات، وبالصدف أيضًا. فيما يتعلق بي، لا شك أنّ الوسط العائلي الذي ترعرعت فيه قام بدورٍ في ذلك. لقد عشت في مدينة مرسيليا، على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. وكانت جدتي لأمي التي كنت مقربًا منها جدًا قد عاشت في قرطبة، وكان أجدادها يتكلمون العربية، كما كانت تروي لي.
عندما أصبحت أستاذًا في المرحلة الثانوية قرّرت أن أحضّر أطروحة الدكتوراة بإشراف الاختصاصي الكبير بالقرون الوسطى ألان دي ليبيرا، الأستاذ في الكوليج دي فرانس. بإمكاني أنْ أقول إنه من أهم من أثر في حياتي الفكرية. وكان دي ليبيرا يؤكد على ضرورة أنْ نقرأ فلسفة القرون الوسطى، اللاتينية والعربية واليهودية (وخصوصًا ابن رشد)، لأنه لا يُمكننا فهم الفلسفة التي تُدعى بالأوربية إلا من خلالها، وهذا ما يتطلب تغيير مركز الفلسفة وتوجيهها في اتجاهات جديدة أخرى، اتجاهات جغرافية، وثقافية، ولغوية، ودينية. وكان يلح أيضًا على أن ننتبه في هذا التاريخ المشترك إلى الفكر «العربي» (بالمعنى اللغوي الشامل والعريض لهذه الكلمة) الذي ترعرع في الوسط الإسلامي.
هكذا، انطلقت في التعمق بالفكر العربي. بدأت بتعلم اللغة العربية (في التسعينيات)، ثم أصبحت أستاذًا جامعيًا وبروفيسورًا (في العام 2011) للفلسفة العربية، وكان هذا منصب الأستاذ في الفلسفة العربية الوحيد في فرنسا. ومنذ ذلك الوقت وأنا لا أتوقف عن الترجمة والتعليم، مع التركيز دائمًا لدى الشباب الجامعي على أهمية الفكر العربي.
● ما رأيك في تأثير الفلسفة العربية في الفكر الغربي؟ أو بالأحرى، بوصفك اختصاصيًا بفكر القرون الوسطى وبالفلسفة العربية، كيف ترى العلاقة بين اللغة العربية والثقافة العربية من جهة واللاتينية والثقافة اللاتينية من جهة أخرى؟
- التأثير كبير وهائل، وهذا واضح وجلي لدرجة أننا لا نستطيع فهم الفكر «الغربي» فهمًا صحيحًا ودقيقًا من دون الفكر العربي، أعني بذلك الفكر الذي كُتب باللغة العربية في الوسط الإسلامي. والقرون الوسطى اللاتينية التي تنطلق منها الفلسفة «الغربية» لم تكن لتوجد مطلقًا كما توجد الآن لولا الفلسفة العربية الإسلامية، وخصوصًا علم الكلام الذي كان واحدًا من مصادرها العربية العديدة. في القرن الثالث عشر، كانت الجامعات «الأوربية» تقرأ أرسطو من خلال ابن سينا (توفي في العام 1037) وابن رشد (توفي في العام 1198). وكان الفكر الأرسطي الأوربي يسترشد في كل شيء بالقراءات العربية التي تقدم المفاهيم والقضايا المتعلقة بالميتافيزيقا وكذلك بعلم النفس وعلم الفلك وبشكل أعمّ بالعلوم كافة. واليوم، لا نستطيع فهم الفيلسوف الفرنسي ديكارت أو الهولندي سبينوزا فهمًا شاملًا إنْ تغاضينا عن الفلسفة العربية، ذلك لأننا لا نفهم من دونها ما الذي يستمران فيه ولا ما الذي ينفصلان عنه.
ومسألة اللغة مسألة جوهرية على وجه التحديد، فعندما نقرأ اللاتينية المستعملة في جامعات القرون الوسطى نجد أنها لغة «تقنية» جدًا، فهي تستوعب «تقنية» اللغة العربية التي كانت هي نفسها قد تكيّفت من أجل التعبير عن الفكر اللاتيني. فاللاتينية تطورت بالعربية التي طورت نفسها، وهي كذلك اغتنت منها. لا يتوقف هذا الأمر على مستوى المصطلحات، بل يتعداه إلى تراكيب الجملة والأسس النحوية، ذلك أن اللغة الفلسفية ليست ثابتة على الإطلاق، ولا هي صافية، بل تزداد وتغتني عبر التاريخ. من هنا نستطيع استخلاص الدرس التالي، وهو درس بسيط ولكنه جوهري ويرتبط بالعلاقة بين «الثقافة اللاتينية» و«الثقافة العربية»: لا يقع الفكر العربي «خارج» الفكر اللاتيني، وهو ليس ضدًا له، ولا آخر مختلفًا عنه، وهو ليس مصدره الوحيد بالطبع، ولكنه عامل رئيس فيه.
تلك هي الفكرة الكبرى: من المفروض ألا نفهم تاريخ الأفكار، تاريخ الثقافات «الفعلي»، بأدواتٍ جغرافية أو سياسية أو عسكرية أو حتى دينية، أي بأدوات المعارضة والمجابهة. الحقيقة إنما تكمن في العلاقة الداخلية التي هي «التخصيب». ما أريد فعلًا أن أقوله هو أن ديناميات التفاعل الثقافي تخضع في مجملها لمنطقٍ غير منطق المجابهة أو الصدام، إنما هي نتيجة الاستعارة والتوارث والتبادل والانطلاق الجديد.
● أنت وضعت عدة مؤلفات في «العقل»، وخصّصت آخرها للمقارنة بين طريقة التفكير عند العرب وطريقة التفكير عند الغربيين، وسيصدر هذا الكتاب قريبًا في ترجمته العربية... هل من الممكن أن تشرح لنا بسرعة ما الفارق بين هذين التفكيرين؟
- هناك فوارق لا بد من رؤيتها وقراءتها وفهمها، لكن لا بد من الاحتراس أولًا والابتعاد عن الأحكام المسبقة (التي يمكن أن نقول عنها بالتأكيد إنها «استشراقية»)، وهي تقضي بمواجهة التفكير الغربي الذي يهتم بالذاتية (هذا موضوع «الأنوار»)، والعقلانية، ووعي الفرد والشخص، وما يوجد عند العرب من شعر وروحانيات وتجاوزٍ للفردية من أجل تفضيل «الكون الأكبر» الذي فيه ينصهر كل شيء. يجب الابتعاد عن ترويج الفكرة الخاطئة التي تقول إن العرب هم مفكرو «المطلق» ليس إلا، في حين أن «الغربيين» الأوربيين اللاتينيين هم مفكرو الإنسان المعاصر والإنسانية التي تُجاريه. في هذه الحال، هناك فرديات لا بد من الانتباه إليها. في كتابي «ما يعني أن نفكر؟ العرب واللاتين»، ركزت على مسألة المفردات. ما لفت انتباهي في الفكر العربي على وجه الخصوص أمران على الأقل، هما: أولًا، الفلاسفة العرب أطباء في أغلب الأحيان، أو على علاقة بالطب، فجاء الطب برؤيته الجديدة للدماغ ليزيد ما يقوله الفلاسفة عن العقل. ففي نظر الفلاسفة في ذلك العصر، لا يُعدّ الدماغ عضو الذكاء (ليس للعقل عضو بالنسبة إلى الفيلسوف الأرسطي). ومع ذلك، أدرك الفلاسفة العرب أن هناك أمرًا ما يجري في الدماغ ويسوس نشاط العقل. فاهتموا به، وتوسعوا في دراسة خصائص الدماغ المتعلقة بالتخيل والتي لا يستطيع المرء أن يعيش عقلانياً من دونها. وقد وُلدت في هذا السياق أفكارهم حول الوهم، والفكر، والذكر، فجاء كل هذا في فرضيات مذهلة وعبقرية.
هكذا، وجّهت اهتمامي إلى التغيرات المختلفة (المصطلحية والفكرية) التي تحصل لفكرة «الاتصال» هذه. لقد ورث اللاتينيون هذه الفكرة، وأعادوا إطلاقها، واستخدموها، ولكنهم فضلوا اعتماد مفهوم التفكير الذي يُدرَك على أنه عمل فردي لنفسٍ فردية. ما يُثير إعجابي ودهشتي في الأنظمة الفلسفية العربية هو أنها تقترح رؤية مختلفة لمفهوم الذاتية.
● أنت اختصاصي بالفيلسوف الكبير ابن رشد. لقد كرّست كل حياتك الأكاديمية تقريبًا في تحليل فكره كما في تدريسه... ماذا يعني ابن رشد لك؟ بالنسبة إليك وإلى الفكر الغربي؟ أو كذلك بالنسبة إلى الفكر البشري؟
- فيما يتعلق بي، ابن رشد من قراءاتي اليومية الدائمة، لأنه تقني وشارح دقيق جدًا للفكر الفلسفي. كذلك، أنا أجد في شروحاته وتعاليقه قوة إيحائية عظيمة تتخطّى حتى حدود الفلسفة، وهذا من علامات العباقرة الكبار. أما فيما يتعلق بالفكر الغربي، ابن رشد هو «الشارح»، أي شارح أرسطو والمعلق عليه بامتياز. لقد بنت القرون الوسطى المدرسية نفسها على قراءة أرسطو الذي عادت أعماله إلى البروز في الغرب من خلال ترجماتها اللاتينية، وقد ساهم ابن رشد بشروحه التي تُرجمت إلى اللاتينية أيضًا في المساعدة على فهم هذا الفيلسوف اليوناني، ونستطيع القول إنّ ابن رشد ساهم في عقلنة الفكر الأوربي، وعلّم الأوربيين كيف «يشرحون»، أي كيف يُمارسون القراءة الفلسفية، هذا بالإضافة إلى أنه ترك لهم أيضًا الكثير من المفاهيم والأفكار... أخيرًا، فيما يتعلق بموقع ابن رشد من الفكر البشري، أنا أراه من كبار عباقرة العقل البشري عامة. يجب أن يحتل ابن رشد في تاريخ الفكر البشري المكانة ذاتها التي لأرسطو أو كانط.
● للمواقف الفقهية الإسلامية أثر مباشر في فلسفة ابن رشد... أليس كذلك؟ هل يُمكننا القول إنه مفكر «إسلامي»، بمعنى أنه ليس فيلسوفًا ملحدًا، بل هو فيلسوف يؤمن بالله وبالرسول؟
- هذا واضح وأكيد، لقد كتب ابن رشد في بيئة إسلامية، وهو في نظري وبالتأكيد مفكر إسلامي في المعنى الذي تقوله أنت. لكن، لا بد من التدقيق في بعض الأمور. ابن رشد لا يفتأ يكرّر أن الإسلام أفضل الأديان في العقيدة كما في الشعائر، على الرغم من أن كل الأديان صحيحة بطريقة ما، إلا أن الإسلام الذي ختمها جاء كتتويج لها كلها. كما أنّه يرى أن عظمة الإسلام تأتي من كونه يقدم الحقيقة في شكلها التام، أي في شكلٍ يتلاءم مع الطبيعة البشرية بالتمام والكمال. فالدين لا يتيح للإنسان أن يقوم بالأعمال الحسنة فقط، بل ينقذ الناس بأنْ يدلهم على الحق، والإسلام يقوم بذلك على أفضل وجه وفي شكلٍ لا مثيل له... لماذا؟ لأن الناس لا يتشابهون تمامًا فيما بينهم وليس لهم القيمة ذاتها، على الرغم من أنهم كلهم كائنات بشرية وينتمون إلى طبيعة مشتركة واحدة... أليس من المعتاد التمييز بين النخبة وعامة الناس؟ إلا أنّ القرآن هو الكلام الذي ينطق بالحق ويفهمه الناس كافة. ورسالته إنما تتوجه إلى البشرية جمعاء، لكنْ، والحال هذه، إلام تؤول الفلسفة في كل هذا؟ في نظر ابن رشد، تتفق الفلسفة مع الحقيقة في شكلها الذهني الخالص، وهي ليست صالحة إلا لدى أولئك الذين ينعمون بشيءٍ من الواقع الطبيعي، أي بشيءٍ من الفطرة.
● كانت العربية لغةً عالمية خلال عدة قرون، لقد استعملها رجال عظماء، فلاسفة وعلماء وأطباء وشعراء... في كل العالم المعروف في العصور الوسطى، من الصين إلى جنوب أوربا، مرورًا بالشرق الأوسط وإفريقيا الشمالية، ألا ترى أنّ لغة الضاد لا تزال قادرة على التعبير عن كل جوانب الفكر البشري المعاصر، رغم ما يتضمنه هذا الفكر من تعقيدات ومصطلحات مستجدة جاءت نتيجة الاكتشافات العلمية والتقنية الحديثة؟
- بالتأكيد بمقدورها ذلك، لكنني لا أستطيع أن أحكم إلا من وجهة نظري أنا، كمراقب أوربي ذي نظرة محدودة جدًا. ما أريد أن أقوله في هذا المجال، وما أحاول دائمًا في دروسي وفي عملي أن أجعل الناس يفهمونه هو أن اللغة العربية كانت وستبقى لغة الفكر السامي. يجب أن يكون هذا الأمر بديهيًا ومعروفًا، ولكنه ليس كذلك في نظر عموم الناس الذين اعتادوا على الاعتقاد بأن الفلسفة لم تتكون إلا في اليونانية أو اللاتينية أو الفرنسية أو الألمانية. ونحن لدينا «رسالة» نوعًا ما، وهي أنْ نُذكّر أن العربية لغة الفلسفة وأنه لولا العربية لما كانت اللاتينية ولا اللغات الأوربية المعاصرة على هذه الدرجة من التطور والثراء. أما فيما يتعلق بالعالم المعاصر والتكنولوجيا الحديثة وغيرها، فإنني أستطيع القول بأنني لا أشك لحظة واحدة بقوة اللغة العربية المعاصرة التي عليها بالطبع أن تتطور وأن تتكيف على الدوام، مثلها في ذلك مثل كل اللغات الحية.
● هل تذهب إذن إلى حد توصية الشباب العربي بدراسة الفلسفة العربية القديمة، أو حتى الفلسفة بشكل عام؟ وهل تعتقد أن الفلسفة لا تزال صالحة لشيءٍ ما في أيامنا هذه؟ وإن كان الأمر كذلك، هي صالحة لأي شيء؟
- نعم بالتأكيد. الإجابة بالنفي كارثة كبيرة. ليس هناك من سبيل آخر غير الثقافة والمعرفة وانتقال المعارف. على كل هذا هو الدرس الذي قدمته القرون الوسطى: كل الفلاسفة العرب يردّدون أن الإنسان يتكون انطلاقًا من عقله، ولكن هذا العقل لم يكن في البداية سوى علقة، أي كُمون وإمكانية، ولذلك يجب تنمية هذا العقل. ولا يحصل ذلك إلا من خلال مجهودٍ نقوم به نحن، فهذه مسؤوليةٌ تقع على عاتقنا كلنا. أن تكون كائنًا بشريًا يعني أنّ في عنقك مهمة أساسية، ولك في الأفق وعدٌ واحتمال. أي أنه يجب أن يكون المرء على مستوى المسؤولية... كيف؟ بأن يستعمل عقله.
في أي شيء تفيد الفلسفة؟ هذا سؤال قديم، والأجوبة معروفة. من الممكن أن يكون الجواب: «في لا شيء»، نعم، ذلك لأنها ليست مجالًا «نفعيًا»، مثل غيرها من المجالات، لكن هذه «المجانية» أو «اللانفعية»، هذا اللا جدوى يُحدِّد كذلك عظمتها، بما أن الإنسان لا يعيش إلا من أجل الانتفاع، والاستعمال، والمردود. لكننا يمكن أن نجيب عن هذا السؤال بطريقة أخرى: الفلسفة، أي هذا الشكل من أشكال الفكر النقدي، هي القدرة على الابتعاد، والتعليق، وإعادة المساءلة النقدية، وتقديم الحجج، وتبادل الأفكار، إنها التقليل من العنف، والتقليل من الحماقة، والتقليل من الاستلاب، أو على الأقل عليها أن تكون كذلك.
● أخيرًا، لقد فزت في ديسمبر الماضي بجائزة ابن خلدون/ سنغور، وذلك لترجمتك كتابَ «المختصر» لابن رشد. ماذا تريد أن تقول في هذا المجال، فيما يتعلق بحصولك على هذه الجائزة بالتحديد؟ وما رأيك عمومًا بهذه الجائزة التي تجمع بين الألكسو والمنظمة العالمية للفرنكوفونية؟
- كان شرف عظيم لي أن أنال جائزة على الترجمة (والترجمة عمل جوهري في نظري)، وفي الوقت نفسه على ترجمةٍ قمت بها من العربية إلى الفرنسية. فهذا أمر يُبرِز أهمية اللغة العربية كلغة الفلسفة. والكلمة الأساسية في عملي كفيلسوف، وقد ذكرت ذلك، هي كلمة «الاتصال»، يمكننا أن نقول «همزة الوصل»، إنها كذلك كلمة العبور، والانتقال. ما أجده رائعًا من هذا المنظور هو هذا الرابط بين الألكسو والفرنكوفونية، الأمر الجوهري بالنسبة إلى اللغة الفرنسية هو أن تهتم بعلاقة الارتباط والتبادل مع اللغة العربية ومع العالم العربي.
● إذًا، أنت تنصح القادة العرب بتكثيف الجهود من أجل دعم الترجمة وتشجيعها، مثل أعمال الدعم، والمؤتمرات، والمنح، والجوائز، إلخ... أليس كذلك؟ هل يوجد في نظرك وسائل أخرى من شأنها السمو بحركة الترجمة في العالم العربي؟
- أنت تفوهت بكلام جوهري، نعم بالطبع. هناك ثلاثية أساسية: النشر، الترجمة، الشرح... كل ما يمكن أن يعزز هذه الأعمال مرحب به. ساحة العمل هائلة، وواسعة، وتقنية، ومكلفة جدًا. من الضروري ألا تكون المعرفة قضية اختصاصيين وحسب. على كل، أنا أخالف بهذا الطرح ما جاء به ابن رشد وبعض الفلاسفة العرب الآخرين. لا بد من إزالة الحواجز وأدوات الفصل في المعارف، ولا بد من جعل هذه المعارف في متناول الجميع. من الممكن ربما إعادة إطلاق «بيت الحكمة» الشهير، وتأسيس مراكز فعلية للترجمة.
● إذا طلبت منك توجيه كلمة إلى الطلاب والطالبات الشباب في العالم العربي، ماذا تقول لهم؟
- أقول لهم الكلمة نفسها التي أقولها لجميع الطلاب، إنها كلمة كانط: Sapereaude! أي: «تجرّأ وفكّر بعقلك» ■